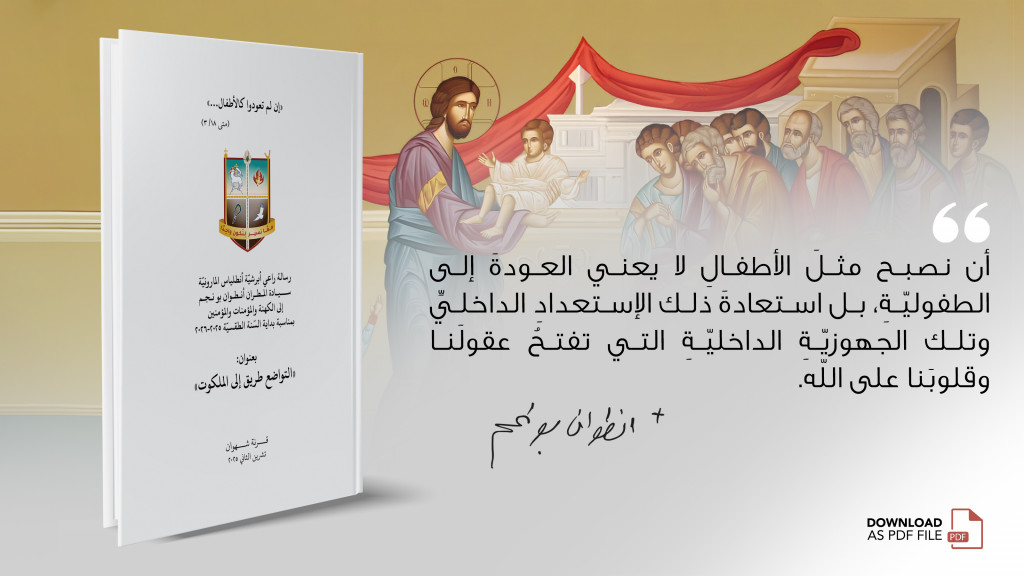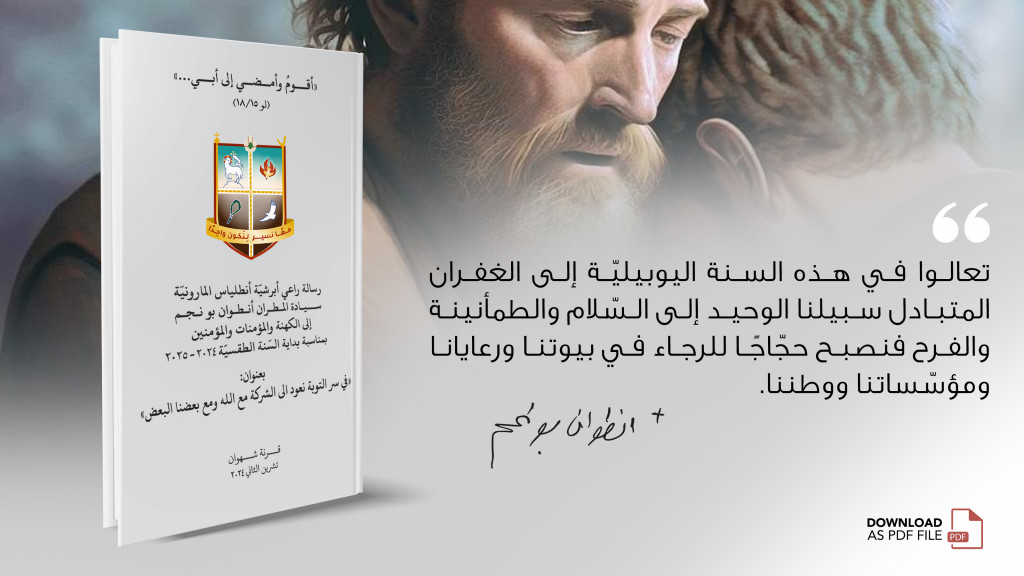الشبيبة والإيديولوجيات

الشبيبة والإيديولوجيات
الشدياق جوزيف متّى
مقالات/ 2018-04-30
غالبًا ما نسمعُ بمصطلحاتٍ تحملُ الكثير من المعاني. منها ما يحمل أهدافًا ومعتقدات لها أبعاد ثقافية، واجتماعية، وسياسيّة، ودينية.
نتطرُّق في هذا المقال على مصطلحٍ ليس بجديدٍ، وهو"الإيديولوجيا". ماذا تعني هذه الكلمة؟ وما تحمل من تأثيراتٍ إيجابيّةٍ وسلبيّةٍ على مجتمعنا؟ وخصوصًا على الشبيبة الّذين يتصارعون بحثًا عن هوية ثابتة. هذه الكلمة تأتي من اللّغة اليونانية: ἰδέα)) إيديا: "فكرة"، و(λόγος) لوغوس:"علم، أو علم الكلام، أو الكلمة"، وتعني الكلمة بكاملها علمَ الأفكار.
إستعمل الكثير من الرؤساء والقادة في التاريخ هذه الكلمة في خطاباتهم، وذلك لأنّها تحمل في تجويفاتها أبعادَ وأفكارَ متراكمة. على سبيل المثال، حين قال الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطابه حول الحرب على العراق: "نحن لا نحتاج إلى إستراتيجيّة مدفوعة بالإيديولوجيا، بل مستندة إلى تقييمٍ واقعيٍّ للحقائق على الأرض ومصالحنا في المنطقة". ما يستطيعُ الشخص فهمه بأنّ هذه العبارة تُعتبر كموقعٍ دفاعيٍّ لمحاربةِ الأفكارِ والمعتقداتِ الّتي تتعلّقُ بالآخر. رأى الفيلسوف ماركس أنّها تعبيرٌ خاطئٌ من قبل المسؤولين لتشريع أفكارهم. ويزيد على أنّهُ موجودٌ في كلّ مكان: في السياسة، والفنون، والقانون، والدين... هذا التعبير الزائف يزحفُ في مجتمعاتنا وهو بحدّ ذاته وعيٌ مزيفٌ، بعيدٌ عن الحقيقة.
في الواقع هذه الأفكار، تُعطي المرء صورةً واضحةً من دون البحث في تثبيتها لأنّها مقنعةٌ ومُبسَّطة، من خلال منطقٍ معيّنٍ يساهمُ في اتّخاذ الخيارات. كما وأنّها تكون قريبةً منّا من دون الشعور بأنها خاطئة. وذلك ما جعلها تجوب في العقول وتسكن وتدوم لسنين كثيرة. حروبٌ وقعت بسببِ الدّفاع عن أفكارٍ خاصّةٍ من دون البحث بها. والإيديولوجيا اليوم تحاكي واقع كلّ مجتمع، إن من حيث الظروف المعيشيّة أو صراع الطبقات الّتي من خلالها تتصرّف الطبقة الحاكمة حسب مصالحها. فهي تجاهد لإيصال أفكارها خادمةً جشعها، عكس ما ترغب أهداف وطموحات الطبقة المحكومة.
ينطلق فرويد ويصف الإيديولوجيا أنها أوهام تخدعنا بها الرغبة الإنسانيّة لتصل إلى هدفها. ويعتقد أنّ للعلم دورٌ في تعرية هذه الأوهام من الحقيقة الخادعة. فهذه الأفكار ليست إلّا رموزًا لا تحتوي على تفسيرٍ واضحٍ، بل هي قناعٌ يخبّئُ وراءه الكثير من الحقيقة. هذا التعبير يشمل أبعاد الحياة كلّها، فهي تصيبُ العديد من الطبقات والفئات خصوصًا الشبيبة. فهؤلاء يبحثون عن هويّة واضحة، والآن نحن نواجهُ جهلًا لهويّتنا وتشويهًا مقصودًا لها. نعم، نحن نعاني جهلًا عميقًا في معرفة هويّتنا الغارقة في بحر الأفكار. لنعرف مدى إدراكنا لجهل هذه الكلمة لنطرح سؤال: من أنا؟
كلٌّ منا سيجيب عن انتمائه إلى وطنٍ أو جنسٍ معيّنٍ أو غير ذلك. إذن، هل الهوية تتعلّق بصفاتٍ معيّنة؟ لكن مهما كان الجواب فنحن نتّجه لصناعة سفّاحين تجاه الهوية، ونحن ندافعُ عن هويّاتنا الّتي أضحت بدورها قاتلة. فالهويّة تُكتسب الآن حسب التعلّم: قل لي من تعاشر أقل لك من أنت. ما يثير الدهشة، أنّ الإنتماء الدينيّ هو العنصر الأبرز في هويّة الإنسان، لما هذا الدافع؟ في كلِّ مرّةٍ نلتقي فيها بأحدٍ، نحاول إبراز انتماءنا أولًا:، "أنا فلان من بلد فلان". بذلك نختصر هويّتنا بالأماكن الّتي تُصوّر انتمائنا الديني. الهُويّة، يصل إليها الإنسان بالانتقال من تجربةٍ فرديّةٍ إلى الوجود كلّه. والهُويّة هي حقيقة واضحة والكون أجمع ينادي بها. فالهُويّة هي تحدّد وجود المرء وثباته في جوهر كيانه. بالإضافة إلى أنّه هو هو ولا شيء آخر.
هكذا، بعيدًا عن أفكار المجتمع الّتي تسودُ وتصرخ في عقولنا وضمائرنا، تبقى هويّتنا هي الانتماء إلى الله الّذي نبحثُ عنهُ بعيدًا عن إيديولوجيات المجتمع. فهي تأتي بحقائق مزيّفة تُبعدنا عن كياننا المُرتبط بالله؟ اليوم أمام كلّ ما يقدّم إلينا من وجوهٍ مقنّعة، أيُّ إلهٍ أختار؟ أأختارُ إلهًا يسجنُنُي في أفكار؟ إلهًا يرفضُ الحريّة؟
تبقى الإيديولوجيّات آلهة لا جذورَ لها تُبعدني عن الله الّذي حرّرني من مصر، عن الله الّذي حرّر عيناي من العمى، عن الله الّذي حرّر جسدي من الموت. اليومَ أُعلن أنّ الله ليس فكرةً أتعلّقُ بها، بل هو إلهٌ حيٌّ يدعوني كلَّ يومٍ إلى التحرّر. وأعلنُ أنَّني سجينُ الحريّة، وأنا اخترتُها طاعةً للربّ، الّتي من خلالها أصرخُ أن المسيح قام وداس الشيطان وكلّ ما يكبلني ويبعدني عنهُ.