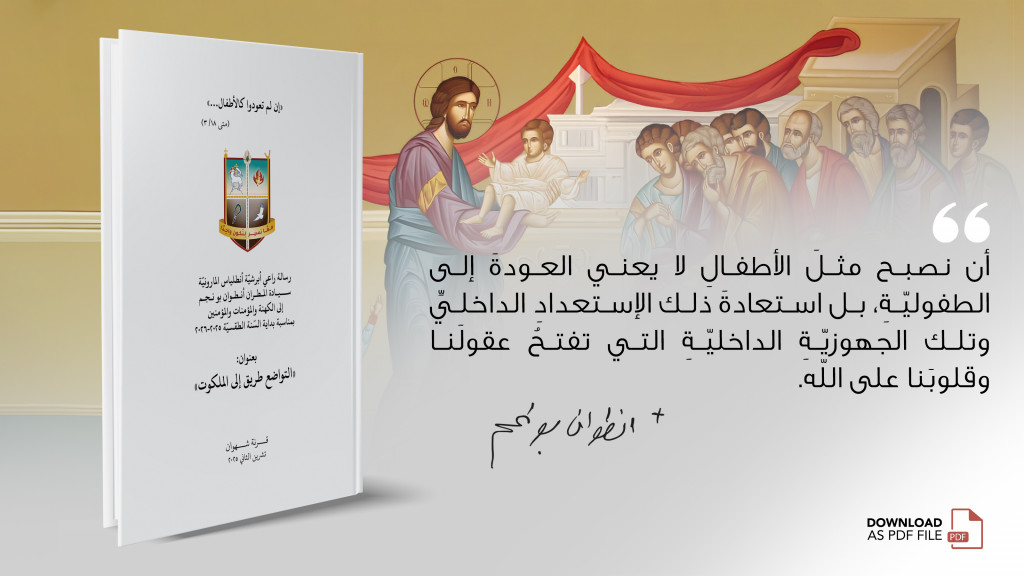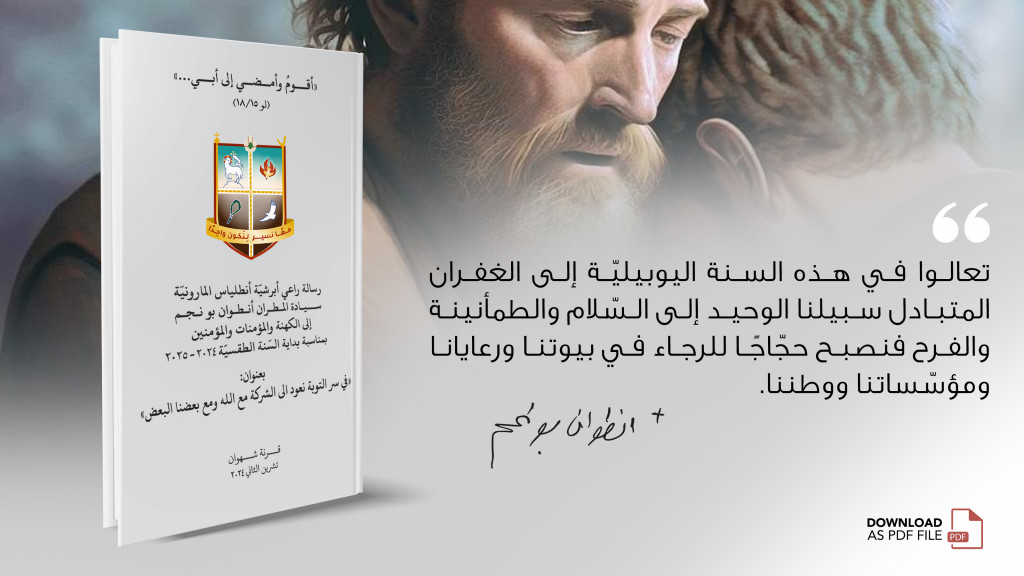أين تقيم؟

أين تقيم؟
الخوري جورج كامل
مقالات/ 2017-09-09
ما أن سمع التلميذان معلّمهما يوحنا، حين دلّهما على المسيح، حمل الله، حتى أخذا يتبعانه (يو 1/ 37). ولما التفت إليهما ورآهما يتبعانه، سألهما: «ماذا تريدان؟» فقالا له: «يا معلّم، أين تقيم؟» (يو 1/ 38).
أين ذهبا؟ وأين هو مكان إقامته الفعليّ؟ أفي الجليل؟ أم في الناصرة تحديدًا، أو على ضفاف بحيرة طبريّة، في كفرناحوم؟ أم على المذبح، وفي بيت القربان، في الأيقونة، في الصليب...؟ أين تقيم؟ صرخة مدوّية، وأيادٍ منبسطة... وتبقى فارغة...
يذكّرنا هذا المشهد، ويوحنا الإنجيلي هو الذي يكتب، بذهاب بطرس ويوحنا بسرعة إلى القبر، ليجداه فارغًا. ويتابع الإنجيليّ: «ثمّ عاد التلميذان إلى حيث يُقيمان» (يو 20/ 10).
ويذكّرنا أيضًا بمريم التي كانت واقفةً خارج القبر تبكي، وهي تبحث عن مكان إقامته. «لقد أخذوا ربّي، ولا أعلم أين وضعوه!» (يو 20/ 13). وعندما ناداها باسمها: "مريم"؛ همّت بإمساكه، فقال لها يسوع: «لا تتمسّكي بي!» (يو 20/ 17). وأجاب الملاكان النسوة اللواتي سابقن الفجر ليحنّطن جسده، «لماذا تطلبن الحيّ بين الأموات؟» (لو 24/ 5). وعُدنَ إلى الجماعة الحائرة... فالقبر فارغ!
«أين تقيم؟» هو السؤال الأساس الذي يتردّد في قلبنا ويرافق خطواتنا. « وَيْنَك ؟ »، خاصّةً في لحظات الضعف وفي المصيبة وفي المرض وفي الفشل... وينك؟ لكنّي لا أجد جوابًا، ولا أسمع له صوتًا، يفرّج كربتي، وينشلني، ويشفيني... أين أنت؟ أين تقيم؟ وتتلاحق الأسئلة بشكل تصاعديّ، نحو الأسوأ... هل أنت موجود؟ أو إنّي أكلّم ذاتي، أطارد سرابًا، ولا أحصد سوى الخيبة؟
يا معلّم: أين تقيم؟ ويجيبهما يسوع قائلاً: «تعاليا، وانظرا! فذهبا ونظرا أين يقيم» (يو 1/ 39).
نحن أيضًا نخرج من بيتنا لنبحث عن مكان إقامته. ومجتمعنا، هو ذاك الذي ننتمي إليه من الخارج، من خلال السكن، والوظيفة، واللغة، والمناسبات على أنواعها... من خلال مظهرنا الخارجيّ، وسيارتنا، وحسابنا المصرفيّ... نبحث عن الشبع، والارتواء، والأمان، والفرح، واللذة... كلّ ذلك لأننا اعتدنا أن نجد الأجوبة في أيّ مكان خارج ذاتنا. ويشير يسوع إلى مملكته قائلًا، ليست هنا أو هناك!
والذين أتقاسم وإياهم السكن، والأقارب، وزملاء العمل... أينما أقاموا هم خارج ذاتي. لكنّ الإقامة الأكبر، بالرغم من بعد المسافات، والأصعب بُـعد الزمان، يقيمون في حنايا فكري وخلجات قلبي وحنيني.
ولأنّه يحبّني، لا بل هو الحبّ بكلّ أبعاده، لم يكتفِ بإقامة خارجية، بعيدة. اقترب بخفَرٍ، بتجليات وكلمات مودّة على ألسنة مرسلين وأنبياء. ولم يردعه علياؤه عن الهبوط، حتى لبس جبلتنا واتشح لاهوته بترابنا، وأقام بيننا في الناصرة وكفرناحوم، وجال في مدن وقرى الجليل، وحجّ إلى أورشليم، وعرّج على كنعان. وشدّه حبّه الجارف إلى أعمق من الأرض بسهولها وقممها ووديانها، حتى أعماق جحيمنا، وإلى زوايا القلب وباطن خليقته، التي تلهف للقياه دون القدرة على الإمساك به، فلقينا هو وأمسك بنا، لأنه لم يستطع الإمتناع عن الانسكاب في أعماق ينابيعنا العطشى.
ونحن الذين نبحث عن القدرة خارج ذاتنا، برفقة شعور بالضعف والعجز، ونستعطي النجاح والشفاء والمغفرة والخلاص... يجيبنا بِلا تخف! أنت فقير لكنك غني، أنت ضعيف لكنك قوي، أنت صغير لكنك عظيم، أنت ميت لكنك حيّ... فأنا اخترتك لي المسكن.. لقد هُدم الهيكل، وبُنيتَ أنت بدموع ووجع وموت... القبر في الخارج هيكل فارغ، وأنت هيكلي حيث أقيم.
مريم! لماذا تبكين، لن تجدي حبيبك حيث تبحثين. عودي إلى بيتك حيث تسمعين خلجات قلبك ومشاهد أحلامك وشوق نفسك، ستلتقين بي حيًّا.
«فأقاما معه ذلك اليوم، وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر» (يو 1/ 39).
ونعترض على الظلم في العالم، واللاعدالة، والجوع الذي يفتك بصغار الفقراء، ونهب ثروات الأرض... وكأنّ الخالق غائب، أو ربّما غير موجود!
ولقد دوّى اعتراض توما: لا أصدّق أنّه حيّ، دون أن ألمس...
ووجده وهو في وسط الجماعة... لم يدخل من الباب، فالأبواب كانت موصدة. أتى من حيث يقيم... وطوبى لمن آمن ولم يرَ! فهو يقيم في مكان أعمق من الرؤية، أبعد من المسافات، أقرب من إمكانية لمسه، والإصغاء إليه...
والأبواب الموصدة الخائفة تشرّعت، وخرجت إلى العالم أيدٍ تعطي وتصالح وتشدّد، وتشفي وتغفر، وتزرع الإيمان والحبّ... وعيون تحنّ وتعطف وتشارك الفرح والحزن... وصوت مدوٍّ يقلق المستبدّين والظالمين، وينصف الحقّ، ويوطّد العدالة... ويدفع الثمن! كما ذاك وما دفعه على قمّة الجلجلة...
أين يقيم؟ تعالوا وانظروا أين يقيم! ليس في مكان ماورائي، ولا في الأحاسيس والكلمات، ولا في رائحة البخور ونور الشموع... هو في مكان وزمان محدّدَين.. "وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر"، "والكلمة صار جسدًا".
ونرفع صوتنا مع بولس منشدين، نحن ضعفاء لكننا نشدّد الكثيرين، نحن فقراء ونغني الكثيرين... وأتابع بثقة، "لست أنا الحيّ بل المسيح حيٌّ فيَّ!" آميـــن