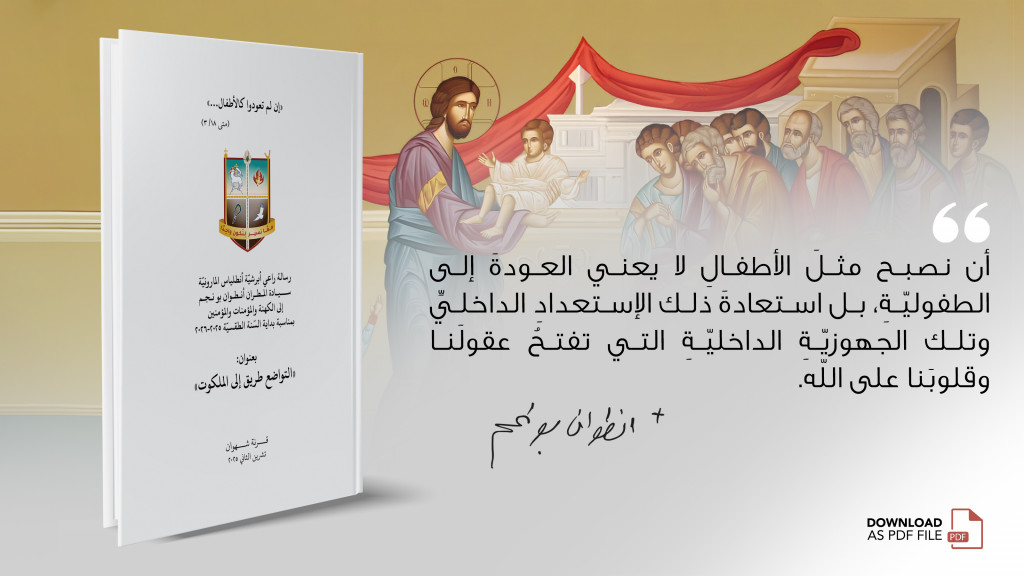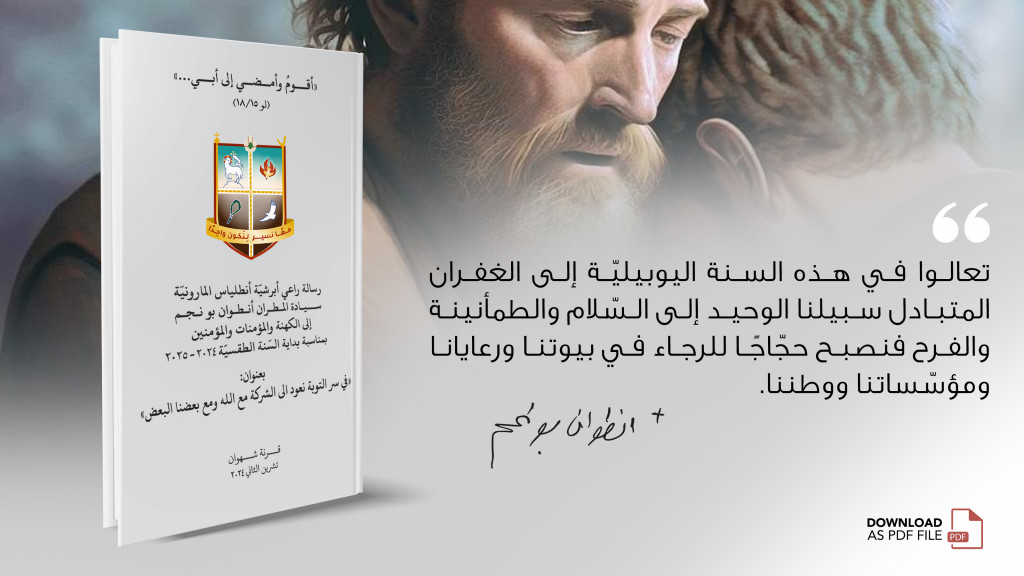نهاية الأزمنة ومجيء ابن الإنسان (متى ف ٢٤ آ١-ف ٢٥ آ٤٦)

نهاية الأزمنة ومجيء ابن الإنسان (متى ف ٢٤ آ١-ف ٢٥ آ٤٦)
الخوري أنطوان القزّي
مقالات/ 2023-09-30
مقدّمة
"قل لنا متى تكون هذه الأمور وما علامة مجيئك ونهاية العالم" (مت 24: 3). سؤال طرحه التلاميذ على معلّمهم بعد أن تنبّأ بخراب الهيكل، وقد يتكرّر السؤال على لسان كلّ إنسان، فالإنسان يميل بطبيعته إلى البحث عن أجوبةٍ على الأسئلة الماورائيّة، علّه يجد فيها بعضًا من الراحة والطمأنينة التي يُنشدها.
يبدو أنّ الرسول متّى، هو الإنجيليّ الوحيد الذي تحدّث أربع مرّاتٍ عن مجيء المسيح في نهاية الأزمنة (la parousie)، ونجدها جميعها في الفصل الرابع والعشرين من إنجيله، حيث يتحدّث عن علامات وزمان نهاية العالم الذي يتزامن حسب رأيه مع مجيء ابن الإنسان: إنّه الإعلان الرؤيويّ للإنجيليّ متّى.
ولأنّ هذا الإعلان يتضمّن أحداثًا مستقبليّة، لا يمكن للأسلوب الرؤيويّ إلاّ أن يعبّر عنه بشكلٍ تلميحيّ وصوريّ: حروب- مجاعات- زلازل- سقوط الكواكب والنجوم... هذه الأحداث الكارثيّة استعملها متّى ليقول شيئًا واحدًا: إن حدث كلّ ذلك، "ليست النهاية بعد" (مت 24: 6) وأيضًا "هذا كلّه بدء المخاض" (مت 24: 8). ولأنّ النهاية، فهي عودة المسيح أو مجيئه، بالتالي فإنّ العالم ليس سائرًا صوب الاضمحلال والخراب، بل صوب الخلاص.
بالعودة إلى سؤال التلاميذ: "قل لنا متى يكون هذا؟" قل لنا "ما هي علامة مجيئك وانتهاء العالم؟"، سؤالان يحدّدان مسار الخطاب النهيويّ للرسول متّى، بحيث أجاب يسوع على السؤال الثانيفعدّد العلامات التي تتزامن ومجيئه (مت 24: 1-35). أمّا السؤال الأوّل، فقد أكّد يسوع أنّه لا يمكنه أن يجيب عليه: "أمّا ذلك اليوم وتلك الساعة، فما من أحدٍ يعلمهما، لا ملائكة السماوات ولا الابن إلاّ الآب وحده" (مت 24: 36). هذا ما حدا بيسوع إلى الحديث طويلاً عن ضرورة السهر والاستعداد الدائم والمتواصل للقاء الربّ عند مجيئه (مت 24: 27- 25: 30)، وقد عبّر يسوع عن ذلك في أمثالٍ ثلاثة: مثل الوكيل الأمين (مت 24: 25-51)، مثل العذارى (مت 25: 1-13) ومثل الوزنات (مت 25: 14-30). بعدها يختم متّى خطابه الإسكاتولوجيّ بحدث مجيء ابن الإنسان في المجد ودينونة جميع الأمم (مت 25: 31- 46).
فيأتي تصميم الفصلين 24 و 25 للرسول متّى على النحو التالي:
أ- مقدّمة (مت 24: 1-3) يُنبئ فيها يسوع عن خراب الهيكل، مّما دفع بالتلاميذ إلى طرح السؤالين عليه: متى تكون النهاية، وما هي علامات مجيئك.
ب- القسم الأوّل (مت 24: 4-36)
- (آ 4-14) يحذّر فيها يسوع رسله من الذين يضلّون الكثيرين، وكيف ستّتحد الأمم من أجل البغض والانقسامات.
- (آ 15-28) يستعرض فيها يسوع الضيق الذي لم يحدث منذ إنشاء العالم (آ 22-26) وعندئذٍ يكون مجيء ابن الإنسان (آ 27).
- (آ 29-31) هذا المجيء بحسب الرسول متّى هو ظاهر ومُعلن، لذا يستنجد متّى بعدد من العلامات المأخوذة من العالم اليهوديّ: تتزعزع السماء (آ 29) وتظهر علامة ابن الإنسان على السحاب لكي يجمع المختارين (آ 30-31).
- (آ 32-35) مثل التينة التي منها نتعلّم كيف نعرف علامات الأزمنة، وأنّ كلام يسوع ثابت ولا يزول.
ج- القسم الثاني (مت 24: 37- 25: 30)
في هذا القسم يؤكّد يسوع أنّ هذا المجيء وإن كنّا لا نستطيع تحديد زمنه، إلاّ أنّه حدث آنيّ، ممّا يدعو إلى الاستعداد والسهر الدائمين.
- (آ 37-44) ضرورة السهر لأنّ المجيء يكون في وقتٍ لا نخاله ولا نعرفه.
- (آ 45-50) ضرورة أن يكون الخادم أمينًا وحكيمًا وذلك استعدادًا للمجيء.
- (25: 1-13) ضرورة الاستعداد والسهر لملاقات العريس ساعة مجيئه: مثل العذارى الجاهلات والحكيمات.
- (آ 14-30) الاستعداد لا يكون بالخوف والتقوقع، بل باستثمار الوزنات التي أعطاها الربّ لكلٍّ منّا.
د- خاتمة الخطبة (مت 25: 31-46) مجيء ابن الإنسان ودينونة الأمم، بحيث صوّره متّى ملكًا جالسًا على عرشه يدين ويفصل بين الخراف والجداء.
بعد هذه المقدّمة الطويلة والمفصّلة، سنُبحر سويًّا في رحاب الفصلين 24 و25 للرسول متّى، وذلك من خلال: تحليل نصوص الفصلين المذكورين ننتقل بعدها إلى قراءة لاهوتيّة وعقائديّة حول الفكر الإسكاتولوجيّ والنهيويّ للإنجيليّ.
أوّلاً: تحليل النص
عندما خرج يسوع من الهيكل، دنا منه التلاميذ يلفتون نظره إلى أبنية الهيكل. فأجابهم: "أترون هذا كلّه؟ الحقّ أقول لكم: لن يُترك هنا حجر على حجر، من غير أن يُنقض" (مت 24: 2). وعند وصولهم إلى جبل الزيتون، دنا منه التلاميذ مجدّدًا وسألوه: "قُل لنا متى تكون هذه الأمور، وما علامة مجيئك ونهاية العالم؟" (مت 24: 3).
نلاحظ أنّ السؤال الذي طرحه الرسل على معلّمهم، يحمل أبعادًا أو مستوياتٍ ثلاث: "قُل لنا متى تكون هذه الأمور (دمار الهيكل) وما علامة مجيئك (باروسيا= مجيء ابن الانسان) ونهاية العالم؟"
المستوى الأوّل الذي يحمله السؤال في طيّاته، هو دمار الهيكل وأورشيم، وقد حصل ذلك سنة 70 على يد الجيش الروماني. فالبعد الأوّل من السؤال، لم يرَ فيه التلاميذ أبعد من هذه الوجهة التاريخيّة. إذ لا يمكنهم أن يدركوا بعد المستوى الرمزي لجواب يسوع حول دمار الهيكل، والذي لم تكتشفه الكنيسة الأولى إلاّ بعد قيامة يسوع. ويوم دوّن متّى إنجيله، كان الهيكل وأورشليم قد دُمّرا.
المستوى الثاني مجيء ابن الانسان (باروسيا). لا شكّ في أنّ هذا البُعد من سؤال التلاميذ، نتلمّس فيه بعض فكر "الغيورين" الذين يقولون بأنّ المسيح سيدخل إلى أورشليم، فيطرد منها الرومان ويضع يده عليها. إلاّ أنّه في زمن متّى، لم يعد لمجيء ابن الانسان هذا المعنى عينه: لأنّ متّى كتب إنجيله، وكانت أورشليم قد دُمّرت، والجماعات اليهوديّة تشتَّتت ويسوع نفسه قد مات وقام، فلا قيمة بعدُ لدخوله إلى المدينة لتحريرها. فالمجيء إذًا هو مجيء مجيد لعودة الربّ.
المستوى الثالث نهاية العالم. طرح التلاميذ على المعلّم سؤالاً حول علامة المجيء ونهاية العالم دفعةً واحدة. على مثالهم قد نمزج نحن أيضًا ونُماهي بين هذين الحدثين ونحدّدهما في وقتٍ من الزمن.
يبدو أنّ هذا التمييز على مستوى الأبعاد الثلاث في سؤال التلاميذ، يساعدنا على فهم النصّ بشكلٍ أفضل، إذ صار بإمكاننا أن نعلم متى يتكلّم يسوع عن دمار الهيكل ومتى يتكلّم عن مجيئه ونهاية العالم. لكن أنستطيع أن نميّز حيث رفض متّى نفسه أن يميّز؟ فمعنى هذه الأحداث الثلاث: دمار الهيكل، مجيء ابن الانسان ونهاية العالم، لا يمكن أن ينكشف إلاّ إذا رفضنا أن نفصلها بعضها عن بعض.
١. مقدّمة الخطبة الإسكاتولوجيّة
ربطت مقدّمة الخطبة الإسكاتولوجيّة عند متّى مجيء ابن الانسان (باروسيا) بالتعليم الذي أعطاه يسوع في الهيكل: "ودخل الهيكل، فدنا إليه عظماء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلّم وقالوا له: بأيّ سلطان تعمل هذه الأعمال؟ ومن أولاك هذا السلطان؟" (مت 21: 23).
في الأساس، إنّ كلمة يسوع في الهيكل في (مت 24: 2)، لا يُنبئ فيها عن دماره القريب، بل تعود بالأحرى إلى هيكل جسده كما يقول الإنجيليّ يوحنا: "أمّا هو فكان يعني هيكل جسده" (يو 2: 21)، وكما يشير متّى نفسه ومرقس خلال محاكمة يسوع أمام المجلس الأعلى (السنهدرين): "ومَثَلَ آخر الأمر شاهدان فقالا: هذا الرجل قال: إنّي لقادرٌ على نقض هيكل الله وبنائه في ثلاثة أيّام" (مت 26: 61). "نحن سمعناه يقول: إنّي سأنقض هذا الهيكل الذي صنعته الأيدي، وأبني في ثلاثة أيّام هيكلاً آخر لم تصنعه الأيدي" (مر 14: 58).
فهيكل الله في أورشليم، بنظر اليهوديّ، يحمل مدلولاً عميقًا: فهو يمثّل حضور الربّ وسط شعبه، وقد قام يسوع بنقل هذا المدلول إلى شخصه: فهو عمّانوئيل أي الله معنا، إنّه الله وسط شعبه. إلاّ أنّ الكنيسة هي من أعادت قراءة كلام يسوع حول الهيكل وكأنّه نبوءة تتحدّث عن دمار هيكل أورشليم وذلك على ضوء القيامة. فحين انفرد التلاميذ بيسوع ليسألوه، أراد هو إدخالهم إلى سرّ "الهيكل" الذي لن يُكشف إلاّ بحدث موت الربّ وقيامته.
٢. مجيء ابن الإنسان ونهاية العالم (مت 24: 4-36)
٢. ١. ضلال الكثيرين (مت 24: 4-14)
الكلّ يعلم أنّ الأزمات تشكّل بيئة حاضنة وخصبة لظهور حركات مسيحانيّة، تضلّ الناس وتقنعهم بانتظار مسيح يقيم نظامًا جديدًا. والأمر جليّ في زمن متّى الإنجيليّ (80 – 90 م) المليء بالمقلقين السياسيّين الذين ضلّوا الناس فساروا وراءهم: "فقد قام ثودَس قبل هذه الأيّام، وادّعى أنّه رجل عظيم، فشايعه نحو أربعمائة رجل..." (أع 5: 36). ناهيك عن المسحاء الدجّالين الكذّابين الذين نشطوا في تلك الفترة: "يا بنيّ، إنّها الساعة الأخيرة. سمعتم بأنّ مسيحًا دجّالاً آتٍ وكثيرٌ من المسحاء الدجّالين حاضرون الآن. من ذلك نعرف أنّ هذه الساعة هي الأخيرة" (1 يو 2: 18).
كلّ هذا ولّد الحروب والكوارث، بالتالي زرع الخوف في قلب الإنسان، وأثبت أنّ وجود الإنسان سريع العطب، مّما حدا به أن يطرح السؤال حول خلاصه الحقيقيّ. "هذا كلّه بدء المخاض" (مت 24: 8)، استطاع متّى أن يرى في كلّ هذه الآلام مخاض الولادة، وهذا يؤكّد أن لا حياة إلاّ بعد ألم و "موت". ولأنّ الله هو سيّد التاريخ وخالق الكون، وحده يمكنه أن يكشف في كلّ هذه الآلام ولادة الملكوت. فلماذا الخوف إذًا؟
بعد الضلال المتأتّي عن المسحاء الدجّالين تأتي الاضطّهادات، فتصيب المؤمنين "وستُسلمون عندئذٍ إلى الضيق وتُقتلون، ويبغضكم جميع الوثنيين من أجل اسمي" (مت 24: 9)، هذه الاضطّهادات نواجهها بالثبات، فيكون ثباتنا شهادةً صادقة وجليّة عن حقيقة التزامنا، وشهادتنا هذه –أي ثباتنا في وجه الاضطّهادات- هي بشارة إنجيل الملكوت التي ستُعلن في كلّ مكان، وبعدها تكون النهاية: "وستُعلن بشارة الملكوت هذه في المعمور كلّه شهادةً لدى الوثنيين أجمعين، وحينئذٍ تأتي النهاية" (مت 24: 14).
بالتأكيد فإنّ متّى لا ينظم شعرًا، ولا كلامًا فارغًا لا يُصرف بمكان، بل هو استند إلى أحداثٍ تاريخيّة مؤكّدة، من اضطّهاد العالم اليونانيّ لليهود إلى اضطّهاد اليهود للمسيحيّين، ورأى كيف أنّ حامل كلمة الربّ يلاقي المقاومة والرفض والاضطّهاد في كلّ زمانٍ وفي كلّ مكان، وهذا يُثبت أنّ إعلان الإنجيل يقود حتمًا إلى الموت.
٢. ٢. الضيق العظيم (مت 24: 15-22)
عاد الإنجيليّ متّى إلى العهد القديم وتحديدًا إلى نبوءة دانيال، ليُعلن علامات النهاية: "حين ترون رجاسة الخراب قائمة في المكان المقدّس" (دا 9: 27). طبعًا هو يلمّح إلى تدنيس الهيكل على يد "أنطيخوس إبيفانيوس" الذي بنى بحسب كتاب المكابيّين الأوّل، تمثالاً للإله "زوس" ووضعه على مذبح المحرقات وذلك سنة 167 ق.م
لا شكّ، يمكن للقارئ أن يفهم من ذلك أن متّى يتحدّث عن دمار هيكل أورشليم على يد الرومان. لكن يمكننا أن نرى أيضًا أكثر من ذلك. "فرجاسة الخراب" تدلّ على الجحود في إيمان الشعب. أمّا هروب الذين يقيمون في اليهوديّة إلى الجبل، شبيه بهرب لوط وعائلته إلى جبل مدينة صوغر (تك 19: 17-22). إنّه هروب أمام هجمة العدوّ المفاجئة، فإيمان المؤمنين يمرّ في محنة قد تصل بهم إلى الجحود.
لكن إن عُدنا إلى نبوءة دانيال، فهمنا أنّه عند بلوغ المحنة ذروتها، عند ذاك يتحقّق الخلاص: "وفي ذلك الزمان ينهض ميخائيل، رئيس الملائكة العظيم الذي يعتمد عليه بنو شعبك، ويكون وقت ضيق لا مثيل له منذ كانت الأمم إلى ذلك الزمان. ولكن في ذلك الزمان ينجو من شعبك كلّ من يوجد اسمه مكتوبًا في الكتاب" (دا 12: 1). على خطّ دانيال، تنبّأ يوئيل فقال: "يوم الربّ مقبلٌ وهو قريب. يوم ظلمة وغروب، يوم غيم وضباب" (يوء 2: 1-2). لكن بالرغم من ذلك ستأتي الدينونة ويكون الخلاص.
أمّا أيّام المحنة والآلام "فقد قُصّرَت" (مت 24: 22) يقول متّى. بمعنى آخر، سيأتي الإيمان الحقيقيّ، ويوقف مدَّ الجحود الذي لا يمكن للربّ أن يُطلق العنان لقوّته المدمّرة.
٢. ٣. تمييز المجيء (مت 24: 23-28)
مع الآية 23 يعود الإيمان إلى الظهور من جديد، وهذا الإيمان يحمي صاحبه من الضلال الناتج عن المسحاء الدجّالين والكذّابين الذين لن يفوّتوا فرصة ضلال "المختارين لو استطاعوا". ولأنّ هذا الإيمان هو حضور الله وسط شعبه، سوف يساعدهم على تمييز الملكوت حين يتجلّى، رغم إصرار الأنبياء الكذبة على دعاياتهم المضلّلة: "فسيظهر مسحاء دجّالون وأنبياء كذّابون، يأتون آياتٍ عظيمة وأعاجيب حتّى إنّهم يضلّون المختارين أنفسهم لو أمكن الأمر" (مت 24: 24).
أمّا تمييز الملكوت، لا ولن يكون على مستوى السماع: "قالوا لكم" (مت 24: 26)، بل على مستوى الإدراك الباطنيّ كما هي الحال في قراءة "علامات الأزمنة": "ودنا الفرّيسيّون والصدّوقيّون يريدون أن يُحرجوه، فسألوه أن يريهم آية من السماء. فأجابهم: "عند الغروب تقولون صحوٌ، لأنّ السماء حمراء كالنّار. وعند الفجر: اليوم مطر، لأنّ السماء حمراء مغبّرة. فمنظر السماء تحسنون تفسيره، وأمّا آيات الأوقات فلا تستطيعون لها تفسيرًا" (مت 16: 1-3).
أمّا استعمال متّى لصورة البرق: "وكما أنّ البرق يخرج من المشرق ويلمع حتّى المغرب" (مت 24: 27)، فهو يدلّ على عنصر المفاجأة لمجيء ابن الانسان، كما تدلّ على طابع يجعل الكلّ يراه، بالتالي هم لا يحتاجون لمن يقول لهم أنّه هنا أو هناك.
أمّا النسور والطيور الكواسر المجتمعة حول الجثث، فهي تدلّ على الخراب والدّمار العظيمين بحسب النبيّ إرميا: "لذلك تجيء أيّامٌ، يقول الربّ، لا يُقال فيها توفةٌ ولا وادي ابنِ هنّوم، بل وادي القتل، ويدفنون فيه موتاهم فلا يبقى موضعٌ، وتصير جثث هذا الشعب مأكلاً لطير السماء وبهائم الأرض ولا من يزجرها" (إر 7: 32-33).
٢. ٤. مجيء ابن الإنسان (مت 24: 29-31)
وصف مجيء ابن الإنسان (آ 29-31)، يستند فيه متّى إلى ما قرأه في العهد القديم، بحيث يصوّر الانقلاب الكوني الذي يُحدثه هذا المجيء. فإن عدنا إلى كتاب أشعيا على سبيل المثال، نرى هذا الانقلاب الكوني الذي استند إليه متّى، كما استند إليه أيضًا (مرقس 13: 24-27) و (لوقا 21: 25-27): "كواكب السماء ونجومها لا تعود ترسل نورها، والشمس تظلم عند طلوعها والقمر لا يضيء نوره" (أش 13: 10).
أمّا ما لمّح إليه متّى عن "علامة ابن الانسان" التي تظهر في السماء: "وتظهر عندئذٍ في السماء آية ابن الانسان" (مت 24: 30)، اعتبرها المفسّرون تلميحًا إلى صليب المسيح أو إلى المسيح نفسه الذي يُتمّ "جذر يسّى" فيصبح علامة تجمع الشعوب: "في ذلك اليوم يرتفع أصل يسّى رايةً للشعوب. تطلبه الأمم ويكون موطنه مجيدًا" (أش 11: 10). أمّا صورة الملائكة الذين يُرسلهم ينفخون في البوق: "ويُرسل ملائكته ومعهم البوق الكبير" (مت 24: 31)، فهي تذكّر القارئ بظهور سيناء بحسب ما يصفه كتاب الخروج: "وكان صوت البوق يرتفع جدًّا وموسى يتكلّم والله يجيبه بقصف الرَّعد" (خر 19: 19). كما وتذكّره بالاحتفالات الكبيرة في الهيكل: "ثمّ يهتف الكهنة من سلالة هرون بالأبواق المصنوعة بالفضّة المطروقة، فيرتفع صوتٌ عظيم يذكّر العليّ بشعبه" (سي 50: 16). وصوت البوق يرمز أيضًا إلى عودة الشعب المشتَّت إلى أورشليم: "وفي ذلك اليوم يُنفخ في بوقٍ عظيم، فيجيء المشتَّتون في أرضِ أشّور، والمشرّدون في أرض مصر، ويسجدون للربّ في الجبل المقدّس في أورشليم" (أش 27: 13).
كلّ هذا يُبرز شيئًا واحدًا وأكيدًا، ألا وهو البُعد المسكونيّ للدينونة النهائيّة: مجيء ابن الإنسان في المجد يدعو جميع البشر، التاريخ كلّه، الكون كلّه، وسوف يُدان كلّ واحد أمام شخص يسوع وليس مَن يُفلت.
٢. ٥. حضور الملكوت (مت 24: 32-35)
من الآية 32 يركّز متّى على الحضور الآنيّ للملكوت في العالم. فهو ليس حدثًا مستقبليًّا، بل حدث حاضر آنيّ. ويعطي مثل التينة التي إن لانَت أوراقها عرفنا أنّ الصيف قريب، لذلك فالذي يدفع بنا إلى تحمّل كلّ هذه الشدائد والآلام هو أنّ مجيء الربّ صار قريبًا. يوم الربّ هو دائمًا قريب: "إذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: يقول المعلّم: إنّ أَجَلي قريب..." (مت 26: 18). إلاّ أنّ هذا اليوم ليس قريبًا في المطلق، بل هو كذلك فقط للإنسان الذي يترك الملكوت ينمو فيه: "وبدأ يسوع من ذلك الحين ينادي فيقول: "توبوا، فقد اقترب ملكوت السماوات" (مت 4: 17).
للوهلة الأولى يتبيّن للقارئ تعارضًا واضحًا ما بين الآيتين 34 و 36، فالأولى تبدو وكأنّها تحدّد زمنًا للمجيء، في حين أن الآية 36 تؤكّد أنّ "ذلك اليوم وتلك الساعة، فما من أحدٍ يعلمهما، لا ملائكة السموات ولا الابن، إلاّ الآب وحده". (مت 24: 36). إلاّ أنّه يبقى تعارضًا على مستوى الظاهر فقط، فربّما نحن أمام تقليدين، تحدّث الأوّل عن علامات المجيء" والثاني عن "زمن المجيء"، ولكن ليقول لنا بأنّ "الابن" نفسه لا يعرف هذا الزمن. فلمَ نضيّع وقتنا إذًا في البحث عنه؟ إنّه سرّ الله!!!
٢. ٦. الخاتمة (مت 24: 36)
"فأمّا ذلك اليوم وتلك الساعة، فما من أحدٍ يعلمهما، لا ملائكة السموات ولا الابن إلاّ الآب وحده" (مت 24: 36). هذه الآية يختم فيها متّى القسم الأوّل من خطبته النهيويّة، وبها ينقلنا إلى القسم الثاني الذي يتوسّع في كيفيّة السهر والاستعداد لهذا المجيء، كي لا نضيّع وقتنا في البحث عن شيء لن نعرفه لأنّه سرّ الله.
الآية 36 شكَّكَت البعض ومن بينهم نسّاخ الإنجيل، لأنّها بنظرهم تبرز جهل الابن لذلك اليوم وتلك الساعة. لذلك سعى البعض إلى تفسير هذا الجهل على أنّه جهل يصيب مهمّة يسوع على مستوى الوحي لا على مستوى معرفته الشخصيّة. لا بل أكثر من ذلك، رأى البعض في هذه الآية أنّها تُظهر بوضوح التمييز بين معرفة الابن ومعرفة الآب. فمعرفة الابن لا تجد أصلها في ذاتها، بل في مدى علاقتها بالآب. هذا يعني أنّ رسالة الابن الأرضيّة تخضع خضوعًا جذريًّا في الزمان والمكان للآب. فكائن يسوع بكليّته كائنًا بنويًّا، لهذا استعمل متّى في الآية 36 لفظة "الابن" ولم يقل ابن الانسان أو ابن الله.
أضف إلى ذلك، إنّ يسوع رفض أن يعطي تاريخًا للدينونة الأخيرة ولنهاية العالم، فهذا الحدث يفلت من حساباتنا، بل هو حدث يخضع كلّه لقرار الآب الذي لا يمكن للعقل البشريّ أن يلِجَه ويدركه، على أنّ الابن نفسه يسلّم مصيره الأرضيّ ووجوده البشريّ لمشيئة أبيه السماويّ بخضوعه التامّ له.
فلا الابن إذًا ولا حتّى الملائكة يمكنهما معرفة ذلك اليوم وتلك الساعة. فكلّ ذلك يحصل ساعة يرى الآب ذلك. إلاّ أنّ هذا الوقت يختلف بين إنسانٍ وآخر. فزمن كلّ إنسان هو زمن علاقته بالربّ من جهة وزمن موته ونهاية حياته الأرضيّة من جهة أخرى. لذلك نقول أنّ حضور الربّ هو حضور آنيّ في كلّ وقت وفي كلّ لحظة من لحظات حياتنا، ولا سيّما عند ساعة موتنا. فنهاية العالم بالنسبة إلى كلّ واحد منّا هي ساعة الموت، لأنّها الساعة التي فيها ينتهي هذا العالم بالنسبة إلينا فندخل إلى الأبديّة. وتبقى النهاية العامّة التي تنتظرها البشريّة، وتنتظرها الكنيسة، وهذا ما نعيشه في كلّ احتفال إفخارستيّ فنتذكّر موت الربّ ونعترف بقيامته حتّى مجيئه.
٣. آنيّة اليوم والساعة وأهميّة السهر (مت 24: 37- 25: 30)
مع الآية 37 ننتقل إلى القسم الثاني من الخطبة، وفيها يحثّ متّى الإنجيليّ المؤمنين على السهر، كي لا نضيّع الوقت في البحث عن زمن النهاية. ويختصر الإنجيليّ هذا القسم في ثلاثة أمثال: الخادم الأمين الذي ينتظر عودة سيّده (مت 24: 45-51)- العذارى العشر وتأخّر العريس (مت 25: 1-13)- العبيد الذين نالوا الوزنات وسيطالبهم سيّدهم بالحساب (مت 25: 14-30).
٣. ١. حثٌّ على السهر (مت 24: 37-44)
لأنّ تحديد موعد المجيء يبقى سرًّا في قلب الآب وحده ولا يمكن للإنسان أن يدركه، ولأنّنا لا نستطيع أن نتوقّع متى يأتي ابن الانسان ، فمن الضروريّ إذًا أن نسهر ونستعدّ.
بدايةً، استشهد متّى بالعهد القديم وتحديدًا عاد إلى (تك 6: 6-12)الذي يحدّثنا عن زمن نوح، فبين مجيء ابن الانسان وما حدث في زمن نوح تقارب كبير. ففي زمن نوح، اهتمّ عدد قليل من الناس بالمسألة الأساسيّة ألا وهي علاقتهم بالله، فانشغلوا بالأمور الحياتيّة والماديّة: "فكما كان الناس، في الأيّام التي تقدّمت الطوفان، يأكلون ويشربون ويتزوّجون ويزوّجون بناتهم" (تك 24: 38). امّا متّى فإن عاد إلى زمن نوح، لا ليُظهر هذا الإفراط بالأكل والشرب وملذّات الحياة، بل ليبيّن لنا غياب كلّ إدراك حقيقيّ للواقع، والابتعاد عن الجوهر: "وما كانوا يتوقّعون شيئًا، حتى جاء الطوفان فجرفهم أجمعين، فكذلك يكون مجيء ابن الانسان" (مت 24: 39).
إنّه تمامًا الواقع الذي نعيشه اليوم: غاب الله ولم يعد له من مكان في مجتمعنا، فنأكل ونشرب وننغمس في ملذّات هذه الحياة. ولكن المفارقة تبقى في حضور الله بالرغم من غيابه. وهذا الحضور يتجلّى في سؤالنا حول الموت. فالموت تهديد صارخ بدمار هذه الحياة التي تشدّنا إليها، وبالتالي الموت يضعنا أمام خيار تحديد وتقييم علاقتنا بالله.
هذا التهديد نفسه (التهديد بدمار شامل)، دفع بنوح إلى أن يحدّد موقعه تجاه الله، ويرى فيه سيّد الخليقة والتاريخ. أمّا معاصروه فلم ينظروا إلى الربّ بل إلى ذواتهم ورضوا عن أعمالهم. هكذا يكون حضور الله في العالم لكليهما: يؤخذ واحد (في الموت) ويُترك الآخر (في الحياة): "يكون عندئذٍ رجلان في الحقل، فيُقبض أحدهما ويُترك الآخر. وتكون امرأتان تطحنان بالرّحى، فتُقبض إحداهما وتُترك الأخرى" (مت 24: 40-41).
دون أن يميّز بين رجل وامرأة، وفي قلب انهماكاتنا اليوميّة (الحقل والرّحى)، يأتي إلينا الموت بغتةً دون أن نتوقّعه ولا يستطيع أن يفلت منه أحد. هنا تكمن أهميّة السهر. لماذا؟ لأنّنا بكلّ بساطة لا نعرف في أيّ يوم يأتي الربّ، فهو يأتي كالسارق ليلاً... فالسهر لا يعني أن نقفل باب بيتنا كي لا يتمكّن السارق من إتمام مهمّـته، بل أن نكون حاضرين ومستعدّين لمواجهة الربّ عند ساعة موتنا. عند ذاك نتعرّى من كلّ الأقنعة الكاذبة التي تُخفي حقيقتنا: "فاسهروا إذًا، لأنّكم لا تعلمون أيّ يوم يأتي ربّكم. وتعلمون أنّه لو عرف ربّ البيت أيّ ساعة من الليل يأتي السارق لَسَهَرَ ولم يدع بيته يُنقب. لذلك كونوا أنتم أيضًا مستعدّين، ففي الساعة التي لا تتوقّعونها يأتي ابن الانسان" (مت 24: 42-44).
٣. ٢. أمثال ثلاثة عن السهر (مت 24: 42- 25: 30)
يقدّم متّى ثلاثة أمثال متتالية تعبّر عن شيءٍ واحد: يجب علينا السهر والاستعداد بانتظار اليوم والساعة اللذين لا نتوقّعهما (مت 24: 50-25: 13). أمّا البنية الداخلية لهذه الأمثال فهي تتضمّن ثلاثة محطّات:
محطّة أولى فيها توزّع المسؤوليات: تدبير البيت (مت 24: 45)، الذهاب للقاء العريس (مت 25: 1)، المتاجرة بالوزنات (مت 25: 14-15).
محطّة ثانية تتجلّى فيها بوضوح حالة الانتظار. من "تأخّر مجيء السيّد" (مت 24: 48)، إلى "انتظار العريس" (مت 25: 5)، إلى عودة الربّ "بعد زمن طويل" (مت 25: 19).
أمّا المحطّة الثالثة والأخيرة، تتميّز بعودة الربّ، حيث يتمّ الفرز والتمييز بين الذين كانوا أوفياء وأمناء لمسؤولياتهم والذين تخلّوا عنها وأهملوها.
أ- مثل الوكيل الأمين (مت 24: 45-51)
في مثل الوكيل الأمين أو الخادم الأمين، تتجلّى صورة السهر من خلال الأمانة للمسؤولية التي ألقاها السيّد على عاتقه. فإن عدنا إلى الإطار التاريخي والاجتماعي للجماعة المتّاوية، يتبيّن لنا أنّ هذه الجماعة اختبرت ضعف المسؤولين المؤتمنين على خدمتها وعدم أمانتهم لمسؤوليتهم. فالوكيل "الأمين الحكيم" هو من يهتمّ "بأهل بيته، فيعطيهم الطعام في وقته" (مت 24: 45)، أمّا الخادم الشرّير، هو "من يضرب أصحابه، ويأكل ويشرب مع السكّيرين" (مت 24: 49). هذا الأخير يريد أن يعيش خدمته بحسب روح العالم، بحثًا عن مصالحه الشخصيّة، لا بحسب روح المسيح.
كلّ مسؤول يمكنه أن ينتقل من موقف إلى آخر، إلاّ أنّ تصرّف كلّ واحد منّا لن يظهر إلاّ في عودة السيّد، ليميّز من كان أمينًا ومن تخلّى عن خدمته. كما تتبيّن لنا المقابلة التي اعتمدها متّى بين تطويبة الوكيل الأمين الحكيم: "طوبى لذلك الخادم الذي إذا جاء سيّده وجده منصرفًا إلى عمله هذا!" (مت 24: 46) والمصير التعيس لذاك الخادم الشرّير الذي "يأتي سيّده في يومٍ لا يتوقّعه، وساعة لا يعلمها، فيفصله ويجزيه جزاء المنافقين" (مت 24: 50-51).
تعود بنا هذه الصورة إلى الويلات التي قرأناها ضدّ رؤساء الشعب الذين تخلّوا عن مسؤولياتهم وعقابهم النهائيّ على ذلك: "الويل لكم أيّها الكتبة والفرّيسيّون المراؤون، فإنّكم تقفلون ملكوت السموات في وجه الناس، فلا تدخلون، ولا الذين يريدون الدخول تدعونهم يدخلون" (مت 23: 13).
"فقال الملك للخدم: "شدّوا يديه ورجليه، وألقوه في الظلمة البرّانية. فهناك البكاء وصريف الأسنان" (مت 22: 13).
ب- مثل العذارى (مت 25: 1-13)
من خلال مثل العذارى الذاهبات للقاء العريس يتبيّن لنا موقفين يُحكم عليهما في نهاية المثل: حضور أو غياب العذارى في لحظة وصول العريس: "وبينما هنّ ذاهبات ليشترين (الزيت)، وصل العريس، فدخلت معه المستعدّات إلى ردهة العرس وأُغلق الباب" (مت 25: 10). موقف العذارى العشر ومدى استعدادهنَّ لملاقاة العريس، يعبّر عن موقف قبولٍ أو رفض يعيشهما الانسان في قلبه منذ البداية: لذا ومن الآية الثانية يميّز متّى بين العذارى فيقول: "خمسٌ منهنَّ جاهلات، وخمسٌ عاقلات" (مت 25: 2). هذا التمييز نفسه سبق واستعمله متّى في تمييزه بين الخادم العاقل والخادم الجاهل (مت 24: 45).
أمّا شرّاح الكتاب المقدّس، فقد استند بعضهم إلى بعض العادات والتقاليد الفلسطينيّة في زمن يسوع، ليفهموا كيف لجأ متّى إلى الاستعارة ليصوّر حاجات الكنيسة. فالأسلوب الذي اعتمده يسوع في هذا المثل، يظهر وكأنّه تصوير لقول نجده عند الإنجيليّ لوقا وإن كان في سياق مختلف: "وإذا قام ربّ البيت وأقفل الباب، فوقفتم في خارجه وأخذتم تقرعون الباب وتقولون: يا ربّ افح لنا، فيجيبكم: لا أعرف من أين أنتم" (لو 13: 25).
تمثّل العذارى العشر، بحسب الإنجيليّ متّى، الجماعة المسيحيّة. فالعدد "عشرة" له رمزيّة مهمّة بحسب التقاليد اليهوديّة: فنحن بحاجة إلى عشرة أشخاص لكي تصحّ الصلاة في المجمع على سبيل المثال. أمّا صفة "العذارى" (البتولات) التي أطلقها متّى على النّسوة، في ذلك عودة إلى التفسيرات الرابّينيّة لكتاب نشيد الأناشيد، بحيث رأوا في جماعته "بنات أورشليم" مجموعة التلاميذ الذين يحملون التوراة ويسهرون في الدرس منتظرين المسيح. و"المصابيح" التي في أيديهنّ هي في الأصل شعلة زيت سيرقصن بها عندما يصل العريس وهم ينشدون أناشيد الفرح. و"الزيت" يرمز إلى الأعمال الصالحة كما يقول العالم اليهوديّ، كما يرمز إلى فرح اللقاء: "ما أطيب وما أحلى أن يقيم الإخوة معًا، فذلك مثل الزيت الطيّب على الرأس، النّازل على اللّحية، لحية هرون، النّازل على طوق قميصه" (مز 133: 1-2). والزيت يرمز أخيرًا إلى العطور التي نسكبها عند استقبال الضيوف والمسحة المسيحانيّة: "تحبّ الحقّ وتكره الشرّ، لذلك مسحك الله ملكًا بزيت الابتهاج دون رفاقك" (مز 45: 8). "وجدت داود عبدي، وبزيتي المقدّس مسحته" (مز 89: 21). من هنا يمكننا أن نفهم لماذا لا تستطيع العذارى الحكيمات أن يعطين من زيتهنَّ للعذارى الجاهلات: "أعطيننا من زيتكنَّ، فإنّ مصابيحنا تنطفئ". فأجابت العاقلات: "لعلّه غير كافٍ لنا ولكُنَّ، فالأولى أن تذهبن إلى الباعة وتشترين لكنَّ" (مت 25: 8-9).
فلسنا هنا إذًا أمام كميّة محدّدة من المادّة (الزيت)، بل علينا الاستعداد لننتظر المسيح بمحبّة قلوبنا. لذا ما من أحدٍ يمكنه أن يسهر عوضًا عن غيره. لذلك، فإنّ وصول العريس كشف حقيقة ومصداقيّة حبّ العذارى: فالحبّ الحقيقيّ مستعدّ دومًا. أمّا الجاهل فيفضّل زيت الباعة على استعداد القلب.
أمّا وقد ذهبنَ إلى الباعة، فقد أتى العريس، فعُدن ووجدن الباب مغلقًا ولا مجال لفتحه. ما المقصود من هذه الصورة؟ نعود إلى نهاية الخطبة على الجبل فنفهمها: "ليس من يقول لي يا ربّ، يا ربّ، يدخل ملكوت السماوات، بل من يعمل مشيئة أبي الذي في السماوات" (مت 7: 21).
المهمّ إذًا، أن نكون حاضرين عند مجيء العريس، ومستعدّين للقائه بزيت الفرح والابتهاج. فعندما نكون بحضرته تنكشف قلوبنا على حقيقتها، لأنّ مجيء السيّد يكشف تصرّف كلّ واحد في زمن الانتظار، شأنه شأن عودته في المثل السابق: "فيأتي سيّد ذلك الخادم في يوم لا يتوقّعه وساعة لا يعرفها" (مت 24: 50)، وفي المثل اللاّحق: "وبعد مدّةٍ طويلة، رجع سيّد أولئك الخدم وحاسبهم" (مت 25: 19).
ج- مثل الوزنات (مت 25: 14-20)
ويأتي مثل الوزنات ليؤكّد ويعمّق مفهوم الاستعداد والسهر في انتظار مجيء الربّ. وهذا المشهد هو مشهد حاسم، فهو يُظهر التعارض بين موقف العبدين الأوّلين والعبد الأخير الذي غضب لأنّه اعتبر أنّ سيّده يطالبه بأكثر مّما أعطاه، فنظر إلى عدالة سيّده على أنّها قساوة، وفاته أنّه هو الجبان. فإن أُعطينا المال فلنستثمره لا ليبقى عقيمًا لا نفع منه.
لذلك إن أمعنّا النظر في الحوار، يظهر لنا أنّ الربّ تبنّى وجهة نظر العبد، وبيّن له أنّه لم يفهم في الأساس مدلول الوزنة التي سُلّمت إليه. فالربّ عندما يهبنا بمجّانية حبّه، يترتّب علينا مسؤولية لإنماء هذه الموهبة لا لطمرها وجعلها عقيمة. فالعبدان الأوّلان صالحين وأمينين: "فقال له سيّده: "أحسنت أيّها الخادم الصالح الأمين!" (مت 25: 21-23) لأنّهما عرفا أن يستثمرا عطيّة الربّ وجعلها في خدمة الآخرين. أمّا الثالث فخاف وانغلق على نفسه وطمر وزنته من أجل مصلحته الخاصّة. فهذا لم يعِ أنّ وزنته هي عطيّة مجّانيّة من السيّد وجب عليه أن يضعها في خدمة الآخرين، بل اعتقد أنّ هذا المال هو لسيّده فلم يتجرّأ على استثماره والمخاطرة به: "فخفتُ وذهبت فدفنت وزنتك في الأرض، فإليك مالك" (مت 25: 25).
أمّا وقد أتى يوم الحساب وإن كان بعد مدّة طويلة وغير متوقّعة: "وبعد مدّة طويلة، رجع سيّد أولئك الخدم وحاسبهم" (مت 25: 19)، فتقدّم العبدين الأوّلين وسلّما ما تاجرا به دون خوف ولا تردّد. أمّا العبد الثالث والأخير استردّ منه السيّد ما وهبه وطرده إلى الظلمة. إنّه مصير الجبناء كما يقول يوحنّا في كتاب الرؤيا: "أمّا الجبناء وغير المؤمنين والأوغاد والقتلة والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذّابين، فنصيبهم في المستنقع المتّقد بالنّار والكبريت: إنّه الموت الثاني" (رؤ 21: 8).
وبعد حوار المحاسبة ما بين السيّد والخدم، عاد متّى إلى الهدف اللاّهوتيّ ألا وهو السّهر. والسّهر لا يعني قبول الكلمة فقط بل المتاجرة بها لتحمل ثمرًا: "وأمّا الذي زُرع في الأرض الطيّبة، فهو الذي يسمع الكلمة ويفهمها فيُثمر ويعطي بعضه مائة، وبعضه ستّين، وبعضه ثلاثين" (مت 13: 23). لذا فإنّ تأخّر الربّ وإبطاء العريس في الوصول وغياب الربّ الطويل في مثل الوزنات، هو مساحة من الحريّة أعطاناها السيّد ليتسنّى لنا أن نتحمّل مسؤوليّاتنا فنتاجر بما وهبنا.
هذا هو معنى هذا الزمن وهذا التاريخ الذي نعيشه بين تجسّد الربّ الذي افتتح الملكوت في وجه الانسان من جديد وكلّفنا متابعة اجتذاب الآخرين إليه، كلٌّ بحسب ما أعطاه من مواهب على قدر طاقته، إلى أن يأتي في مجيئه الثاني لنؤدّي له الحساب.
هذا ما أراده متّى من خلال هذا المثل، فراح يحذّر المسحيّين من التخاذل والكسل واليأس والخوف، حذّرهم من الفتور والتنصّل من المسؤوليّة، لأنّ المسيحيّ يجسّد حبّه بأفعال: فمن أحبّ الله الذي في السماوات، عمل مشيئته ولم يترك أحدًا من إخوته يهلك: "وهكذا لا يشاء أبوكم الذي في السماوات أن يهلك واحد من هؤلاء الصغار" (مت 18: 14).
٣. ٣. الدينونة العظمى (مت 25: 31-46)
يستعيد متّى في هذا المثل أهمّ ما وجدنا في الفصلين 24 و 25، لذا وجب علينا قراءته من منظار هذين الفصلين. "أسئلة عديدة طُرحت حول هذا المثل: فمن هي الأمم المجتمعة (آ 32) عن اليمين وعن اليسار؟ هل هي جميع الشعوب بدون تمييز، أم أولئك الذين سمعوا كلمة الإنجيل وصاروا مسيحيّين، ومن هم "إخوتي هؤلاء الصغار" (آ 40-45)؟ هل كلّ إنسان يعرف الشقاء والضيق، أم التلاميذ وكارزوا الإنجيل الذين نستقبلهم أو نزورهم؟ ويتساءل الشرّاح: هل نحن أمام نصّ يعود إلى يسوع نفسه، أم إلى ينبوع تقليديّ أعاد صياغته مدوّن إنجيل متّى؟" (راجع إنجيل متّى تجلّي الملكوت، الجزء الرابع، الخوري بولس الفغالي، الرابطة الكتابيّة، طبعة أولى 2000، ص. 156-157).
في البداية (آ 31-33)، يستعيد الإنجيل موضوع "مجيء ابن الانسان". فحضور الربّ للدينونة حيث تُجمع لديه كلّ الشعوب والأمم، يدلّ على حدثٍ رئيسيّ: كلّ البشريّة ستمثل أمام الملك ليميّز بين وارثي الملكوت والمطرودين منه.
وصورة الفرز والتمييز هذه ما بين الخراف والجداء ليست جديدة، فهي معروفة منذ العهد القديم: "كلّ بكرٍ فاتح رحمٍ فهو لي، وكلّ بكرٍ ذكرٍ من ماشيتكم من البقر والغنم فهو لي. أمّا بكر الحمير فتفدونه بخروفٍ، وإلاّ فاكسروا رقبته" (خر 34: 19-20). أمّا هذا الفرز وهذه الدينونة، سيقابلها أصحابها بالدهشة دومًا، لأنّه ما من أحدٍ منهم وعى أنّه استقبل أو رفض الربّ في الفقراء والمرضى والمساجين...: "فيجيبه الأبرار: يا ربّ متى رأيناك جائعًا فأطعمناك..." (آ 37- 39- 44).
سعى الشرّاح أن يعرفوا من هم "إخوتي هؤلاء الصغار؟" (آ 44-45)، فعادوا إلى ما قاله متّى: "ومن سقى أحد هؤلاء الصغار، ولو كأس ماء بارد لأنّه تلميذ، فالحقّ أقول لكم إنّ أجره لن يضيع" (مت 10: 42).
"وأمّا الذي يكون حجر عثرةٍ لأحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فأولى به أن تُعلّق الرَّحى في عنقه ويُلقى في عُرض البحر" (مت 18: 6).
"إيّاكم أن تحتقروا أحدًا من هؤلاء الصغار" (مت 18: 10).
"وهكذا لا يشاء أبوكم الذي في السماوات أن يهلك واحد من هؤلاء الصغار" (مت 18: 14).
من كلّ ذلك، استنتج الشرّاح أنّ الصغار هم تلاميذ المسيح، كما أنّ لفظة "إخوتي" تدلّ أيضًا على التلاميذ: "فأجاب الذي قال له ذلك: من أمّي ومن إخوتي؟" ثمّ أشار بيده إلى تلاميذه وقال: "هؤلاء هم أمّي وإخوتي" (مت 12: 48-49).
بالتالي فإنّنا سنحاسب وندان على استقبالنا لتلاميذ المسيح. بمعنى آخر، سندان على قبولنا لكلمته وتعليمه. ومن خلال أعمال الرحمة والمحبّة والاهتمام بالتلاميذ المتألّمين، نصل إلى يسوع نفسه حتى وإن كنّا لا ندري. هكذا يتجلّى التماهي الكلّي بين يسوع وتلميذه المتألّم والمضطّهد.
ثانيًا: البُعد اللاّهوتيّ لنهاية الأزمنة في إنجيل متّى
ما هي "نهاية العالم" أو "نهاية الأزمنة"؟ إنّها بكلّ بساطة، ساعة يقف كلّ واحد منّا في حضرة الله ساعة موته. بالعودة إلى إنجيل متّى، فالنهاية تأتي عندما تُعلن "بشارة الملكوت هذه في المعمورة كلّها شهادة لدى الوثنيّين أجمعين، وحينئذٍ تأتي النهاية" (مت 24: 14).
في هذه "النهاية" يقف كلّ إنسان في حضرة الله الذي يوجّه كلامه بشكلٍ حاسم إلى كلّ واحد ساعة موته، أي لحظة بداية "أبديّته". في هذه اللحظة بالذات يتحدّد مصير الإنسان الشخصيّ ومصير العالم. ولكن هذه اللحظة "النهيويّة" هي لحظة آنيّة، بعبارة أخرى، يتحدّد مصير الإنسان في كلّ لحظة في حياته، بقدر ما يعني أنّه أمام الله وفي حضرته في كلّ عمل أو قول أو تصرّف يقوم به. من هنا يمكننا أن نستنتج أن التعليم "الإسكاتولوجيّ" في فكر القدّيس متّى، هو تعليم أخلاقيّ، لأنّ كلّ عمل وكلّ خيار في حياتنا اليوميّة، يعيشه المؤمن في حضرة الربّ. هكذا إذًا حتّى الأعمال الصغيرة في يوميّاتنا في تحديد مصيرنا في الدينونة الأخيرة حيث محبّة الله ومحبّة القريب يتماهيان فيصبحان وصيّة واحدة.
هكذا نفهم لماذا لم يستطع يسوع أن يجيب عن السؤال حول تاريخ نهاية العالم. فهذا التاريخ في الواقع يختلف بين إنسان وآخر لأنّ ساعة الموت تختلف بين إنسان وآخر.
أمّا بالنسبة إلى الشعب اليهوديّ، بدأ هذا الوعي مع دمار أورشليم: عندما دُمّر الهيكل، وجد هذا الشعب نفسه في لحظة مصيريّة ومفصليّة، لذا ربطوا بين دمار الهيكل ومجيء الربّ، فاعتقدوا أنّ مجيء الربّ قريب لأنّه لم يعد حاضرًا (هيكل أورشليم يجسّد حضور الربّ في وسط شعبه). هذا ما حدا بهم إلى أن يطرحوا سؤالاً حول مصيرهم وحول يسوع: هل يسوع هو المسيح المنتظر؟ هل يمكننا أن ننتظر رجوعه المسيحانيّ؟
كنيسة متّى التي آمنت بموت وقيامة الربّ وعودته القريبة، طرحت هي أيضًا هذا السؤال. وإلى يومنا يبقى هذا السؤال مطروحًا. فأمام موت الربّ وقيامته، يعي كلّ جيل، كلّ إنسان، مجيء الربّ في حياته" (إنجيل متّى تجلّي الملكوت، الجزء الرابع، الخوري بولس الفغالي، الرابطة الكتابية، طبعة أولى 2000، ص. 159).
نهاية الأزمنة في حياة الفرد هي ساعة موته وحضوره في حضرة الربّ، كما ذكرنا سابقًا. ففي حياته، يقف الإنسان أمام خيارين لا ثالث لهما: إمّا قبول أو رفض النعمة الإلهيّة، ويأتي الموت ليضع حدًّا لهذه الحياة وبالتالي لهذين الخيارين. ويوضح العهد الجديد أنّه في حضرة الله، ينال الإنسان جزاءه بشكلٍ مباشر (مثل لعازر والمسكين- كلام يسوع وهو على الصليب للصّ التائب...).
خاتمة
من كلّ ما تقدّم، لا يسعنا إلاّ أن نستنتج أنّه لا بدّ للكنيسة أن تجتاز خطر جحود إيمان أبنائها وفتور المحبّة بينهم، وظهور المسحاء الدجّالين والكذّابين أي الذين يمجّدون أنفسهم بدل تمجيد الله ومسيحه -وهم كثرٌ في أيّامنا- قبل مجيء المسيح. ساعتئذٍ يُكشف سلوك كلّ واحد، ويُقضى على الخطيئة والإثم، وموقف الإنسان تجاه القريب "إخوة يسوع الصغار" هو يحدّد مدى قبول النعمة الإلهيّة أو رفضها لأنّه "ليس كلّ من يقول يا ربّ، يا ربّ، يدخل ملكوت السماوات".
بهذا المعنى تقول الكنيسة الكاثوليكيّة في تعليمها العدد 679:
"المسيح سيّد الحياة الأبديّة. وله الحقّ الكامل في أن يحكم نهائيًّا على أعمال البشر وقلوبهم بكونه فادي العالم. لقد "اكتسب" هذا الحق بصليبه. ولهذا فالآب "فوّض إلى الابن كلّ دينونة" (يو 5: 22). والابن لم يأتِ ليدين، بل ليخلّص، ولكي يعطي الحياة التي فيه. وبرفض النعمة في هذه الحياة يدين كلّ واحدٍ ذاته، فينال ما تستحقّه أعماله، ويستطيع حتّى أن يُهلك نفسه إلى الأبد برفضه روح المحبّة".
فلمَ الانتظار إذًا طالما نعرف السؤال. "فليمتحن كلّ واحدٍ نفسه"ولنطرح السؤال على أنفسنا: هل نحن ساهرون؟ أم نتهرّب من التزاماتنا ونختبئ وراء أعذارنا؟
المراجع
2. Lectio Divina 179, Alberto Mello, Evangile selon Saint Matthieu Commentaire
Midrashique et Narratif, Les éditions Du CERF, Paris 1999, p.p. 416-441
3. كتاب التعليم المسيحيّ للكنيسة الكاثوليكيّة، المكتبة البولسيّة، 1999
4. دراسات بيبليّة، إنجيل متّى تجلّي الملكوت، الجزء الرابع، الخوري بولس الفغالي، الرابطة الكتابيّة، المطبعة البولسيّة 2000، ص. 139-159
5. L’évangile selon Saint Matthieu, Pierre Bonnard, LABOR ET FIDES, 2002, p.p.
345-367