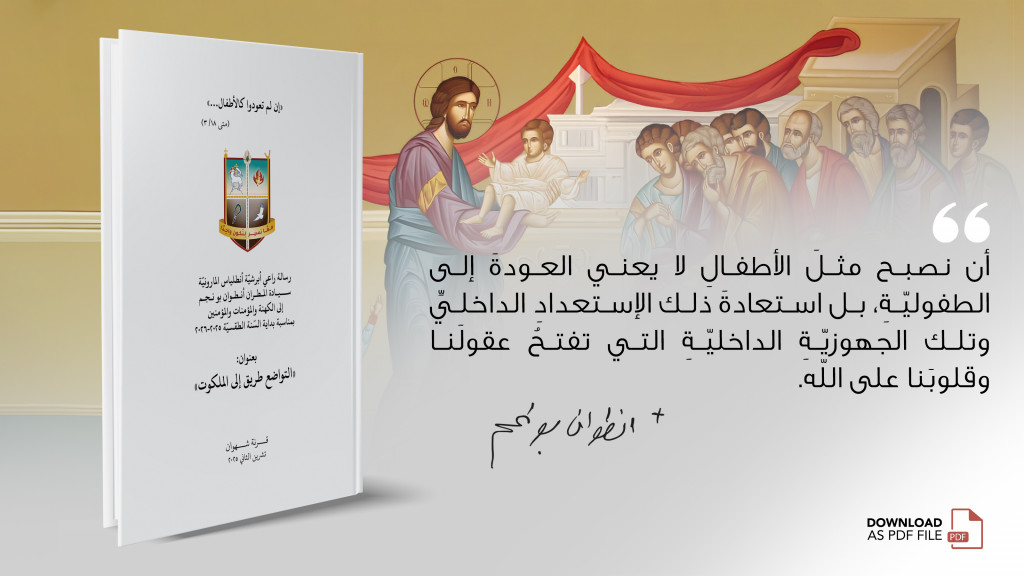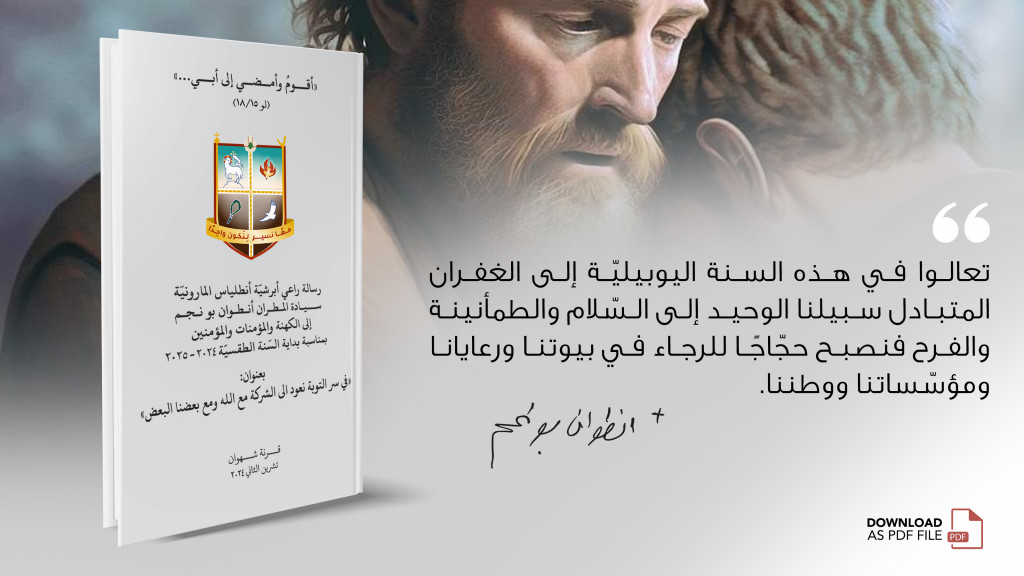الإيمان المسيحيّ والعلاجات الطبّية: تكامل أم تناقض؟

الإيمان المسيحيّ والعلاجات الطبّية: تكامل أم تناقض؟
الخوري سمير حسون
مقالات/ 2021-02-17
كيف كانت العلاقة بين الإيمان والعلاجات الطبّية عبر التاريخ؟
ماذا يقول الكتاب المقدس بعهديه على هذه العلاقة؟
ماذا نتعلّم من آباء الكنيسة؟
ماذا تُعلِّمُنا السلطة الكنسيّة؟
هل يتناقضان أم يتكاملان؟ وكيف؟
مقدّمة
المرض وما يتأتّى عنه من نتائج على حياة الإنسان موضوعٌ شائك ومعالجته تتطلّب مجلّدات من الأبحاث. لذا، ولصعوبة الموضوع وتشعّبه، نحصر مقاربتنا في هذا البحث حول علاقة الإيمان المسيحيّ بالعلوم الطبّية محاولين دراسةَ الإشكالية التالية: يعتقد بعض المسيحيين أن طلب المساعدة الطبّية يشير إلى عدم الإيمان بالله حيثُ أنّ البعض يعمدون إلى التخلّص من أدويتهم وعلاجهم واللجوء إلى الصلاة والأسرار من أجل شفائهم. فالسؤال الأساسيّ هو: ما هي النظرة المسيحيّة للطبّ والأطبّاء كإختصاص علميّ مستقلّ؟ وهل اللجوء إلى العلاجات الطبّية علامةٌ على نقص الإيمان؟ أم أنّ عدم اللجوء إلى الطبّ هو تنكّر لعمل الله؟
تعتمد هذه الدراسة على مقاربة هذه الإشكاليّة على صعد ثلاثة: سنلجأ أوّلاً إلى لاهوت الكتاب المقدّس لنتعرّف على نظرته إلى هذا الموضوع؛ وسنعمد ثانية إلى الإستعانة بتقليد الكنيسة وتعليم الآباء لكي نصلَ ختامًا إلى تقديم بعض الاستنتاجات الرعويّة. وقبل الغوص بكلّ ذلك، نشير إلى أنّنا نستخدم في هذا البحث كلمة "إيمان" بمعنى أنّ الشخص المعنيّ ببحثنا هو شخص "مؤمن" أيّ يرتبط بعلاقة شخصيّةٍ ودينيّةٍ مع الله، مع العلم أنّ هذا الرباط قد ينسجمُ أولاً مع تعليم السلطة الكنسيّة الرسميّ.
1- ماذا يقول الكتاب المقدّس عن الإيمان بالله والعلاجات الطبّية؟
يتميّزُ عالمُ الطبّ عن غيره من العلوم بأنّه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحياة الإنسان وبواقعه اليوميّ. فهو نشأ من حاجة الإنسان إلى مداواة آلامه، وتجاوبًا مع رغبة الإنسان في الحياة وإطالة عمره إن أمكن. أمّا الإيمانُ، فهو التصاق الإنسان بإله يعبده بحثًا عن معنى الوجود والموت والخلود. بناءً على ذلك يمكننا القول بأنّ الطبّ يلتقي مع الإيمان في بحثهما المشترك للإعتناء بحياة الإنسان، لأنّ للإنسان قيمة فريدة.
1.1- الكتاب المقدّس ليس كتابًا علميًّا
لكي نفهم نظرة الكتاب المقدّس لعالم الطبّ، علينا أوّلا الإضاءة على الهدف الأساسيّ لتدوينه. فالكتاب المقدّس ليس كتاب علم (لا فيزياء ولا كيمياء ولا حساب ولا سياسة ولا طبّ...) إنّما هو كتاب إيمان حيّ ينقل لنا الكتّابُ المُلهَمون من خلاله ما كشفه اللهُ عن علاقته بالإنسان. إنّه إعلان بشرى خلاص الإنسان من خلال تاريخ الخلاص. لذا، لا يمكن أن نجد فيه بحثًا فكريًّا عن علم الطبّ ولكن لا بدّ من أن نجد فيه بعض الأجوبة عن بحثتنا حول العلاقة بين الإيمان والطبّ لأنّهما مرتبطان بواقع الحياة الإنسانيّة اليوميّة. إنّ عالم الألم والمرض والصحّة يطال أهمّ جوانب الحياة البشريّة وهو من الأسرار الّتي تفوق عقل الإنسان إدراكًا.
يستخدم الكتاب المقدّس بعهديه كلمات خاصّةً تدلّ على الطبّ كنشاط بشريّ يستند إلى اختبارِ أشكالٍ عديدةٍ من الأمراض الّتي تصيب جسد الإنسان ونفسه. فكلمة "طبيب" ترد في العهد القديم العبري مستخرجة من فعل"ر ف أ" (רָפָא) rapha’ أيّ داوى وشفى. فمن هذا الفعل يشتقّ إسم الملاك رافائيل الّذي يعني: رافا = يشفي؛ إيل = الله، الله الّذي يشفي. فالطبيب هو مداوٍ وشافٍ للمرضى. أمّا النصّ اليونانيّ للعهد القديم (السبعينيّة) كما نصّ العهد الجديد فيستخدمان الفعل (iaomai) "عالج" وكلمة (iatros) "إياتروس" ليشيرا إلى الطبيب الّذي يعالج أمراض الجسد.
ترد كلمة "ر ف أ" بمعنى "عالج، عافى" كما بمعنى"طبيب" (أيّ معالج) في العهد القديم مرّات بصيغة المفرد ومرّاتٍ بصيغة الجمع. أمّا "ياتروس" أي الطبيب فترد 7 مرّات في العهد الجديد. ففي سفر التكوين مثلاً، نستطيع أن نقرأ كيف أنّ الله شفى (ر ف أ) عائلة أبيمالك من العقم (تكوين 20/ 17: فصَلَّى إِبْراهيمُ إِلى الله، فعافى اللهُ أَبيمَلِكَ واَمرَأَتَه وخادِماتِه فوَلَدنَ)، كما نقرأ أيضًا كيف أنّ يوسف لجأ إلى أطبّاء (ر ف أ) ليحنّطن أباه يعقوب (تكوين 50/ 2: وأَمَرَ (يوسف) خُدَّامَه الأَطِبَّاءَ أَن يُحَنِّطوا أَباه، فحَنَّطَ الأَطِبَّاءُ إِسْرائيل).
في الواقع، اهتمّ الطبّ في شعب الله في الأمراض الظاهرة في علامات جسديّة مثل ضعف البصر، والعمى، والعقم، والاحديداب، وبياض العين، والجرب، والكلف، والرضوض، والكسر والبثور، وقرحة مصر، والبواسير،والحكّة، والجنون، والقرحة الخبيثة، والبرص، والفالج، والحمّى، والصرع، والصمم، والبكم، ونزيف الدمّ، وضربة الشمس… لكنّه اهتمّ أيضًا بالآلام النفسيّة والمعنوية مثل ألم فقدان عزيز بالموت، وحرمان النسل، والحنين إلى الوطن، والتعرّض للإضطهادات، والإستهزاء، والوِحدة، ونكران الجميل، ومحن الوطن…
أمّا أبرز السبل إلى العلاجات فيمكن ذكر: الضمّادات، والمراهم الطبيعيّة، والزيت، والخمر، والبلسم، والكعك المصنوع بالتين، والعصائب، والزيت الممزوج خمراً، والدهون، والمراهم، وأصول النبات والأوراق ونوع من الّلقاح (تكوين 30: 14-16)…
ولكن، كيف فهم شعب الله العلاقة بين عمليّة الشفاء وبين المرض؟
2.1- لاهوت الشفاء والمرض
واضح أنّ الألم الناتج عن أمراض الجسد والنفس يصيب الإنسان، كلّ إنسان. لذا، يعمد هذا الأخير إلى البحث عن جواب عن "لماذا" كما عن "كيف أتخلّص من هذه الآلام". وهذه أسئلة صعبة مثلها مثل تلك الّتي تتعلّق بالشرّ. لماذا الشرّ؟ أمام هذا الواقع، قد يلجأ الإنسان إلى طرح أسئلته الوجوديّة على الله (كما على العقل البشريّ). إنّ الكتاب المقدّس يتضمّن وحيًا من الله (وهذا وجه ممّا ندعوه البعد اللاهوتيّ في الكتاب المقدّس) من شأنه أن يجعلنا نفهم على قدر ما يمكننا فهمه شيئًا من أسرار عالم الألم. إنّ قراءةً متأنيّةً ومعمّقةً للاهوت المرض والألم والعلاجات الطبّية تمكّننا من الوصول إلى حقائق عديدة يمكننا عرضُ أبرزها على الشكل الآتي:
˗ خلق الله الإنسان من تراب (تكوين 2/ 7) وهذا يعني بأنّه كائن ترابيّ أيّ ضعيف وزائل بطبيعته. لكنّ الله نفخ فيه "نسمة الحياة" فأصبح الإنسان "غير قابل للفساد" بنعمة خاصّة من الله. فالإنسان لم يكن إذًا خالدًا بطبيعته وإلّا لأصبح إلهًا؛ ولم يكن فاسدًا بطبيعته وإلاّ لكان الله سببَ فساده وموته.
˗ أراد الله أن يخلق الإنسان كائنًا حرًّا وسيّدًا على مصيره. فأعطاء حريّة القرار بالاحتفاظ بحالة النعمة أو رفضها. فعندما دخلت الخطيئة إلى حياته، أصبح الإنسان مائتًا وأبديًّا في آن.
˗ إنّ مفهوم الخطيئة هذه (وهذا ما تدعوه الكنيسة الكاثوليكيّة باسم الخطيئة الأصليّة) يعني أنّ الإنسان أخرج نفسه من دائرة النعمة الإلهيّة، ممّا أدى إلى فقدان قدرته على الحفاظ على جسد لا يعرف المرض والموت.
˗ نتيجة كلّ هذا، لم تصب الأمراض الجسد فقط (فعليه أن يتعب ويشقى ويجاهد لكي يعيش، وعلى المرأة أن تتمخّض لتلد...)، بل دخلت إلى نفسيّته (طغت مشاعرُ الحزن والعذاب والقلق والألم النفسيّ...). كانت النتيجة الكبرى: العودة إلى التراب (تكوين 3/ 19).
˗ لكنّ هذا المرض الّذي أصاب الإنسان امتدّ ليصيب الكون كلّه. وهكذا، حوّل الإنسان عمله ضدّ الطبيعة فأدخل نفسه والكون في دوّامة من الصراع والألم، فأصبحت الأرض (بما تمثّل) ملعونة بسببه (تكوين3/ 17).
˗ عندما نقول أنّ سبب الخطيئة الأصليّة هو آدم، فنحن لا نقصد أنّ شخصًا واحدًا معيّنًا، أيّ هو الإنسان الأوّل، يتحمل لوحده المسؤولية عن حالة الإنسان الراهنة. إذ إنّ كلّ إنسان على وجه الأرض هو مماثل لآدم وشريك معه. هذا ما يؤكّده بولس الرسول: "فكَما أَنَّ الخَطيئَةَ دَخَلَت في العالَمِ عَن يَدِ إِنسانٍ واحِد، وبِالخَطيئَةِ دَخَلَ المَوت، وهكذا سَرى المَوتُ إِلى جَميعِ النَّاسِ لأَنَّهُم جَميعاً خَطِئوا..." (روما 5/ 12).
˗ إنّ صورة آدم الأوّل هي صورة كلّ إنسان منّا: "ضَلُّوا جَميعًا فَفَسُدوا معًا. ما مِن أَحَدٍ يَعمَلُ الصَّالِحات لا أَحَد." (روما 3/ 12). لذا، هناك ارتباطٌ قويٌّ بين خطيئة آدم وخطايا كلّ البشر. هذا ما نسمّيه المسؤوليّة الجماعيّة. كلّ إنسان يتحمّل جزءًا من مسؤولية الأمراض في العالم بسبب شروره.
˗ من هنا نفهم أهميّة سرّ التجسّد. أصبح المسيح إنسانًا ليرمّم ما أفسدته الخطيئة بالإنسان. وحده القادر على ذلك بفضل طبيعته الإلهيّة المتّحدة بالطبيعة الإنسانيّة. وهكذا خلّصنا من نتائج الخطيئة والعصيان، وهكذا أصلح الطبيعة الإنسانيّة وأعادها إلى بهائها الأصلّي.
ولكن لماذا بقي المرض قائمًا؟
˗ صحيح أنّ المسيح أبطل طغيان الشرّير وحطّم الموت بالموت، لكنّه لم يلغِ الخطيئة ولا عمل الشرّ ولا الموت الجسديّ بانتظار اكتمال الزمن الّذي يحدّده الآب بسلطانه. ففي نهاية الأزمنة يتمّ تجديد كلّ شيء (أعمال 3/ 21).
هل يمكننا أن نستنتج بأنّ المرض سببه خطيئة الإنسان الفرديّة؟
˗ لقد ميّزنا بين مفهوم الخطيئة بشكل عامّ والخطيئة الفرديّة بشكل خاصّ. فالخطيئة بشكل عامّ أو ما يعرف بالخطيئة الأصليّة لا تعني الخطايا الفردية إنّما هي حالة الإنسان ككائن حرّ مخلوق قابل لوضع نفسه خارج دائرة النعمة الإلهيّة. أمّا الخطيئة الفرديّة فهي تتّخذ كلّ أشكال الخطايا المعروفة (القتل، السرقة، عبادة الأوثان، الكبرياء...)
˗ يبقى الجسد خاضعًا لقوانين المادّة بسبب طبيعته المادّية. وكجسم حيّ هو يشارك ظروف الحياة كافّةً: قابِلٌ للشقاق والتلف والمرض والموت... كما أنّ هناك قسم كبير من طبيعة جسدنا غير خاضعة للسيطرة لأنّها ليست من خصائص الإنسان. لذا، يختبر القدّيسون المرض والعذاب والألم والموت...
˗ لا شكّ في أنّ بعض الأمراض الجسديّة هي ناتجة عن خطايا فرديّة، مثل البرص الّذي أصاب مريم أخت هارون وموسى تكوين 12/ 10؛ مثل الشخص الّذي يتعاطى المخدّرات أو الّذي يعيش حياةً آثمةً فقد يلتقطُ أمراضًا عديدةً... أمّا القراءةُ المتعمّقة بالأسباب والنتائج فتكشف لنا أنّ مثل هذه الأمراض ليست ناتجة عن عقاب إلهي إنّما عن نتيجةٌ مباشرةٌ لسلوك الإنسان الخاطئ.
˗ يمكننا القول إنَّ التفكير اللاهوتيّ القديم قد رأى رباطًا بين المرض والخطيئة كعقاب إلهيّ. ولكنّ مع تقدّم الاختبارات فهِمَ الإنسانُ أنّه يولد وارثًا جسدًا قابلاً للمرض والموت، وبالتالي فإنّ الأمراض الّتي تصيب الناس ليست دائمًا نتيجة خطيئتهم الفرديّة بل بسبب واقعِ أنّهم يشاركون في الطبيعة الإنسانيّة القابلة للمرض والفساد.
˗ من أبرز الشواهد البيبليّة الّتي تشير إلى أنّ لا علاقة أوّلية بين خطيئة الإنسان الفردية ومرض ما يصيبه أو يصيب أحدًا من ذرّيته نذكر ما يلي:
o ما كشفه لنا الوحي من خلال قصّة أيّوب البارّ مؤكّدًا أنّ ما أصابه لم يكن سببًا لأي خطيئة ارتكبها.
o ما قاله المسيح عن المولود الأعمى كما جاء في إنجيل يوحنّا 9/ 1-3 إنّ فقدان بصره لم يكن سببَ خطيئةٍ ارتكبها أهله أو هو.
o ما فعله المسيح مع المخلّع حين بدأ بمغفرة خطيئته قبل شفاء جسده كعلامة منظورة وحسّية على الشفاء الروحيّ (متّى 9/ 1-6؛ مرقس 2/ 1-12؛ لوقا 5/ 17-26)، فلو كانت خطيئته سببًا لمرضه لكان وقف ومشى بعدما غفر له المسيح مباشرة.
o ما أوصى به القدّيس يعقوب باستدعاء شيوخ الكنيسة للصلاة على المرضى، ماسحين إيّاهم بالزيت موضحًا أنّ الصلاة تشفي المريض دون أن يجزم أيّ علاقة مباشرة بين الخطيئة والمرض إذ أكّد على ما يلي: "وإِذا كانَ قدِ ارتَكَبَ بَعضَ الخَطايا غُفِرَت لَه" (يعقوب 5/ 15). نلاحظ استخدام "إذا" الشرطيّة.
هل يمكننا اعتبار المرض شرًا بذاته؟
˗ بما أنّ المرض هو نتيجةٌ لواقعِ الجسدِ غيرِ السليم ولعلاقةٍ غيرِ سليمةٍ يُعتبر شكلاً من أشكال الشرّ. يقول البابا يوحنّا بولس الثاني في رسالته الرسوليّة "الألم الخلاصيّ": " كلّ ما يؤلّم الإنسان يدعوه الكتاب (المقدّس) "شرّا". واللغة اليونانية وحدها، والعهد الجديد معها، (وترجمات العهد القديم اليونانية)، تستعمل لفظة pasko ومعناها: أعاني من…، أشعر، أتألّم، ولهذا فإنّ الألم، من خلال هذه اللفظة، لا يعني ما يعنيه الشرّ (الموضوعيّ)، بل يشير إلى حالة يقاسي فيها الإنسان شرّاً…"
˗ ولكن، من الزاوية الروحيّة، قد يسمح المريض لله أن يجعل مرضه مصدرًا للبركات، وهكذا يصبح بابًا لخيرٍ أسمى عند البعض. في الألم والشدّة، قد يطلب الإنسان من الله استعادة العافية، ولكن قد يطلبُ منه نعمةً لاحتمال الآلام ومشاركتها مع عمل يسوع الخلاصيّ، أو يطلب تتميم مشيئة الله. من هذا المنظار، يظهر المرض وكأنّه مسموح به من الله لخير الإنسان ولصحّة نفسه: "مَخافَةَ أَن أَتَكَبَّرَ بِسُمُوِّ المُكاشَفات، جُعِلَ لي شَوكَةٌ في جَسَدي (…) وسأَلتُ اللهَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ أَن يُبعِدَه عَنِّي، فقالَ لي: حَسبُكَ نِعمَتي(…) ولِذلِك فإِنِّي راضٍ بِحالاتِ الضُّعفِ والإِهاناتِ والشَّدائِدِ والاِضطِهاداتِ والمَضايِقِ في سَبيلِ المسيح، لأَنِّي عِندَما أَكونُ ضَعيفًا أَكونُ قَوِيًّا" (2 كورنتوس 12/ 7-10).
وهنا يُطرَح سؤالٌ: كيف فهمت الكنيسة العلاقة بين الطبّ والإيمان؟
2- الإيمان والطبّ في تقليد الكنيسة
لقد قدّم يسوع نفسه كطبيب للنفوس والأجساد: "لَيسَ الأصِحَّاءُ بِمُحتاجينَ إِلى طَبيب، بَلِ المَرْضى" (متّى 9/ 12). "لا شكَّ أَنَّكم تَقولونَ لي هذا المَثَل: يا طَبيبُ اشفِ نَفسَكَ…" (لوقا 4/ 23). لم يكن يسوع فقط طبيبًا، إنّما أيضًا أخذ أمراض الناس على عاتقه: "ولمَّا كانَ المساء، أَتَوه بِكثيرٍ مِنَ المَمسُوسين، فَطَرَدَ الأَرواحَ بِكَلِمَةٍ مِنه، وشَفى جَميعَ المَرْضى، لِيَتِمَّ ما قيلَ على لِسانِ النَّبِيِّ أَشَعْيا: هوَ الَّذي أَخذَ أَسقامَنا وحَمَلَ أَمراضَنا" (متّى 8/ 16-17؛ أشعيا 53/ 5). إنّ المسيح، الطبيب الوحيد، أعطى هذا السلطان لرسله (متّى 10/ 1-8؛ لوقا 9/ 2؛ مرقس 6/ 7و13...). فالرُّسلُ والقدّيسون لا يستطيعون الشفاء إلاّ باسم يسوع (أعمال 3/ 12 و16).
إنّ طبابة النفوس والأجساد الّتي قام بها المسيح وتلاميذه من بعده، جعلت الوثنيين يصفون المسيحيّة بأنّها "ديانة المرضى". مع العلم أنّ الأديان في تلك الحقبة لم تكن تقدّر المرضى لا بل كانت تزدريهم (الأبرص، النازفة…). ولكن، وبالرغم من كلّ الشفاءات الّتي قام بها المسيح وتلاميذه لاحقًا، بقي المرض منتشرًا. وهؤلاء الّذين شفوا في مرحلة ما من حياتهم، عادوا ومرضوا وماتوا.
لذا، وبموازاة الوسائل الدينيّة للشفاء (كالصلاة والصوم واللجوء إلى الأسرار المقدّسة وأشباه الأسرار…) لم يتنكّر المسيحيّون لأهميّة العلاجات الطبّية. لا بل على العكس من ذلك، لجأوا إليها واستخدموها، حّتى إنّهم وبفضل اهتمامهم بالمرضى، ساهموا بتطوير منهجيّة التمريض والمستشفيات وذلك في وقت مبكر من انتهاء اضطهاد المسيحيّين.
ينقل لنا الدكتور جان كلود لارشي روايات عديدةً حول العلاقة بين المسيحيّين والطبّ منذ بدايات الكنيسة على الشكل التالي:
- يستعرض لائحة عن أطبّاء مسيحيّين مثل لوقا (كاتب الإنجيل)، إسكندر الفريجيّ، زنوبيوس الكاهن الطبيب من صيدا، بطرس الطبيب، تيبرياس الأسقف، باسيليوس الأنكيري والّذي كان عالمًا في الطبّ، تيودوتوس طبيب وأسقف اللاذقيّة، بوليتيانوس بطريرك الإسكندرية، كما أنّ العديد من آباء الكنيسة أظهروا تقديرًا كبيرًا تجاه فنّ الطبّ، نذكر منهم: غريغوريوس النصّيصيّ، وغريغوريوس النزينزي، وباسيليوس، وإيذيدوريوس.
- لقد بدأ المسيحيّون في روما، منذ سنة 200 تقريبًا، قراءة أعمال غاليانوس الطبّية حتّى إنّهم استخدموا طريقته في التشخيص والعلاج. ومنهم من استخدم أساليب أبقراط في العلاج. أصبحت الأديره والمدارس الكهنوتيّة في بيزنطية مراكز لتعليم فنّ الطبّ.
- بعض آباء الكنيسة أنشأوا المستشفيات، نذكر منهم القدّيس باسيليوس الّذي أنشأ مستشفى في ضاحية قيصريّة سنة 370 مزوّدًا إيّاها بمجموعة من الأطبّاء الأكفّاء؛ والقدّيس يوحنا فم الذهب الّذي أنشأ العدد من المستشفيات في بداية القرن الخامس في القسطنطينيّة.
- على مرّ العصور أنشأ البطاركة والأساقفة والرهبانيات الرجالية والنسائية في الشرق كما في الغرب عددًا من المستشفيات والمستوصفات ومراكزَ للعلاجات الطبّية والّتي ساهمت إلى حدّ كبيرٍ في نشأة وتطوّر الطبّ.
- ولكن، في مقابل هؤلاء ظهرت بعض المواقف المتطرّفة مثل تلك الّتي صدرت عن تاتيانوس وترتليانوس والّتي ترفض اللجوء إلى الطبّ العلاجي. إنّ تفسير هذه الظاهرة لدى البعض مرتبط بواقع تاريخي على علاقة وثيقة ببعض البدع (مثل المونتانية والماركيونية) أو بعالم الزهد والمتزهّدين (مثل مواقف برصنوفيوس ومكاريوس الّلذين اعتبرا أنّ عدم اللجوء الى الطب العلاجيّ هو في إطار الحياة الزهدية والديريّة وليست نهجًا لكلّ المسيحيين. فبالنسبة لهما، إذا كان عدم اللجوء إلى الطبّ سببًا للتعالي ولاعتبار النفس أكثر قوّة وقداسة، فينصحون حينئذ باللجوء إليه كي لا يقعوا في فخّ تجربة الكبرياء). يمكننا فهم وتفهّم هذه المواقف الصارمة والنادرة من زاوية أنّ مطلِقيها يخافون من أن يحتّل الطبّ الأرضي منزلة الله.
تجدر الإشارة أيضًا إلى أنّ موسوعات عديدة من بينها ويكيبيديا تستعرض دراسات تاريخيّةً حول أهميّة الحضور المسيحيّ في عالم الطبّ والعلاجات والاكتشافات والأبحاث العلميّة على أنواعها.
ماذا يمكننا أن تستنتج رعويًّا من كلّ ما سبق؟
3- استنتاجات رعويّة
1. لم يصنع الله المرض (الحكمة 1/ 14). لقد أجمع آباء الكنيسة أنّ الله ليس علّة المرض والعذاب والموت. يقول القدّيس باسيليوس: "من الحماقة أن يؤمن الإنسان بأنّ الله هو سبب عذابنا، هذه هرطقة تقوّض صلاح الربّ."بناءً على ذلك، لا يمكننا اعتبار الله السبب المباشر للأوبئة.
2. يرى المسيحيّ في الطبيب خادمًا لله. وقد أكّد على ذلك الكتاب المقدّس على لسان يشوع بن سيراخ. بل ذهب إلى أبعد من ذلك، إذ كشف لنا بأنّ الفطنة والحكمة تتطلّبان اللجوء إلى العلاجات الطبّية، لماذا؟ لأنّ الربّ هو من خلقها ومن وضع في الإنسان موهبة الفكر لاستخراجها ومعرفة استعمالها:
"أعطِ الطبيب كرامته لأجل فوائده، فإن الربّ خلقَه. لأنّ الطبّ آتٍ من عند العليّ، وقد أفرغت عليه جوائز الملوك. علم الطبيب يُعَلّي رأسه، فيُعجَب به عند العظماء. الربّ خلق الأدوية من الأرض، والرجل الفَطِن لا يكرهها. أليس بِعود تحول الماء عذبًا حتى تعرف قوّته. إنّ العليّ ألهم الناس العلم لكي يُمَجَّد في عجائبه. بتلك يشفي ويزيل الأوجاع، ومنها يصنع العطّار أمزجة، وصُنعَتَه لا نهاية لها. فيحلّ السلام من الرب على وجه الأرض" (يشوع بن سيراخ 38/ 1-8).
3. هذه النظرة إلى عالم الطبّ والعلاجات تبلورت على امتداد 20 قرنًا من تاريخ الكنيسة. فنقرأ عند القدّيس باسيليوس: "كلّ من الفنون المختلفة منحها لنا الله لشفاء ضعف الطبيعة (…) ومن هنا يأتي فنّ الطبّ". أمّا تيودوريتوس القوروشي فقد كتب:
"إذا كانت الأسقام الّتي تصيب الجسد كثيرةً، كثيرةٌ هي أيضًا الأدوية المضادّة، وكثيرةٌ هي الوسائل الّتي اكتشفها الفنُّ الطبّي لمحاربة كلّ مرض. لهذا أنبت الله الخالق من الأرض الكثير من النباتات، من غذائيّة وغيرها، لأنّ الإنسان ليس بحاجة فقط إلى الغذاء إنّما إلى العلاج أيضًا..."
4. بحسب التقاليد المسيحيّة، الأورثوذكسيّة والكاثوليكيّة،هناك عدد من القدّيسين شفعاء للأطباء، مثل القدّيسيّن لوقا الإنجيلي الطبيب، وكوزماس، وداميان من القرن الثالث، وكوينتين وهو جرّاح من فرنسا، والقديس فوليان من أيرلندا، والقديس روش من فرنسا؛ والقدّيس أتاغاتا، وألكسيوس، وكاترينا الإسكندرانية، وكاترينا من سيناء، ومارغريت من أنطاكية، وغيرهم…، بدون أن ننسى أنّ الملاك رافائيل هو أيضًا شفيع الأطبّاء.
5. لا شكّ أنّ عبر تاريخ الكنيسة، كما في كلّ الأديان، ظهرت بعض الأصوات الّتي رفضنتِ اللجوءَ إلى فنّ الطبّ وعلاجاته تحت شعار الإساءة إلى الله، الطبيب الوحيد. مع أنّ هؤلاء هم أقلّية، لكنّهم تركوا أثرًا في بعض الأوساط الشعبيّة المتديّنة خوفًا من المسّ بالعزّة الإلهيّة، ومنهم من كان موقفهم هذا سببًا لموت الآلاف من الناس بأوبئة عديدة لأنّهم رفضوا اللقاحات. وهنا على سبيل المثال لا الحصر، نذكر كيف أنّ بعض المتديّنين ما زالوا حتّى الآن يرفضون اللقاحات ضدّ الحصبة حتّى إنّ بعض الراشدين لا زالوا يتوفّون بسببها. من الواضح تاريخيًّا أنّ كلّ لقاح جديد كان يثير الكثير من الإعتراضات خصوصًا في الأوساط الدّينيّة، وبعد ما يقضي على مئات الناس، يضطرّ الكثيرون إلى قبوله.
6. ولكن، لا سبب دينيّ منطقيّ لرفض اللجوء إلى العلاجات الطبّية ومنها اللقاحات. النظرة الإيمانيّة واللاهوتيّة تؤكّد أنّ الله هو الطبيب. ولكنّ الله يستخدم فكرنا البشريّ من خلال علم الطبّ لينقل لنا عنايته بنا. الإهانة الكبرى لا تكمن في تلقّي العلاجات الطبّية ومن ضمنها اللقاحات، إنّما عدم تلقّيها، لأنّنا بذلك نتنكّر لحضور الله وعنايته من خلال العلم والأطبّاء.
7. يعرض الإنجيل لنا مثل السامريّ الصالح (لوقا 10/ 25-37). في ضوء هذا الإنجيل نسأل أنفسنا: هل يجوز للإنسان "القريب" أن يمرّ بقرب مريض بلا مبالاة؟ أليس المسيحُ هو من يطلب منّا أن نستقبل المريض في "فندقنا" ونعتني به، ساكبين على جراحه "دواءً" مفيدًا؟ إذا ما رفضنا العلاج الطبّي ومن ضمنه اللقاحات نكون بحالة تنكّر لرغبة المسيح، ألا وهي أن نساهم في الحفاظ على حياة كلّ إنسان.
8. مع كلّ ما سبق، يجب ألاّ ننسى بأنّ المسيح قد وضع أدوات روحيّةً لشفاء النفس والجسد من بينها الأسرار المقدّسة. إنّ اللجوء إليها بالإيمان هو تعبير صادق عن أنّ الله هو الطبيب الأسمى لنفوس البشر وأجسادهم. لكنّ الله يصنع المعجزات أقلّه بطريقتين:
- أوّلاً، من خلال تدخّلٍ مباشرٍ منه (مثل الأعاجيب والمعجزات) وهذا أمر نادر نسبيًّا (إذا ما أحصيناعدد الّذين يشفون نسبة لعدد المرضى) ومع ذلك، هؤلاء الّذين يُشفون يعودون ويمرضون…
- ثانيًا، من خلال عمله في الطبيعة أيّ من خلال الأدوية والعلاجات الطبّية والفكر البشريّ.
9. لا شكّ في أنّ التطوّر الطبّي قد يذهب به البعض إلى تطرّف يناقض الإيمان (مثل تسهيل الإجهاض والتلاعب بالأجنّة البشريّة...). هنا لا بدّ من تدخّل ما يعرف بالأخلاق الطبّية الّتي تتدخّل لوضع حدّ لكلّ ما قد يتخطّى حدود الكرامة الإنسانيّة وقيمة الحياة البشريّة وقدسيّتَها.
10. المقياس إذًا هو قدسيّة الحياة. إذا ما كان الطبّ لا يتنافى معها فلا يجب رفض علاجاته.
خاتمة
ختامًا، يبقى الإنسان هو القضية المحوريّة في كلّ شيء. كلّ ما قام به الله عبر تاريخ الخلاص يهدف إلى دفع الإنسان الحرّ إلى اتّخاذ قرار بعدم الإنفصال عنه. كلّ ما قام به المسيح يهدف إلى افتداء الإنسان والتأكيد له بأنّ الله مستعدّ أن يموت كلّ يوم حبًّا له.
من أجل خير الإنسان، كلّ إنسان، خلق الله الكون والطبيعة، ووضع فيها مقوّمات حياة الإنسان، ومن ضمنها العلاجات المتنوّعة لشفاء جراحات جسده ونفسه. قد يتخطّى الإنسان حدود محدوديّته معتقدًا بأنّه "الخالق"، وهنا يخسر نعمة الله فيه. أمّا إذا عرفَ الإنسانُ مكانته، مطيعًا اللهَ وعاملاً بمشيئته، فإنّه يكون بذلك حكيمًا وأمينًا لمشيئتِه.
لقد أسّس البابا القدّيس يوحنّا بولس الثاني منذ عام 1992 اليوم العالمي للمريض ودعا للإحتفال به في 11 شباط من كلّ عام، في ذكرى عيد سيّدة لورد. ومذّاك الوقت وإلى الآن، حافظ البابوات على هذا التقليد، مصدرين رسالةً خاصّةً في هذه المناسبة، مؤكّدين من خلال هذه المحطّة على أهميّة عيش الألم ببعد خلاصيّ ولشكر الله على نعمة الطبّ والأطباء وكلّ العاملين في حقل الطبابة.
فليكن الله الثالوث مباركًا من خلال كلّ أعمالنا. وليحفظ العاملين في الحقل الطبّي بعنايته ملهمًا إيّاهم أن يعملوا كلّ ما في وسعهم لإنقاذ البشريّة المتألّمة، واضعًا يده بيدهم ومستعملاً علمهم وعقلهم ليكتشفوا علاجات مفيدةً لأوجاع النفس والجسد. نسأله ذلك بشفاعة أمّنا مريم العذراء وجميع القدّيسين، أمين.