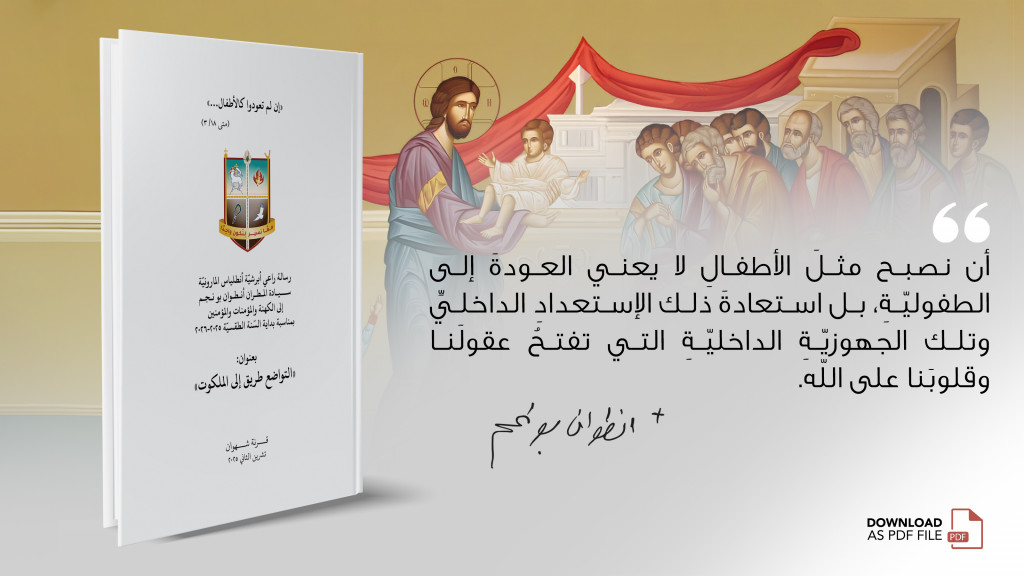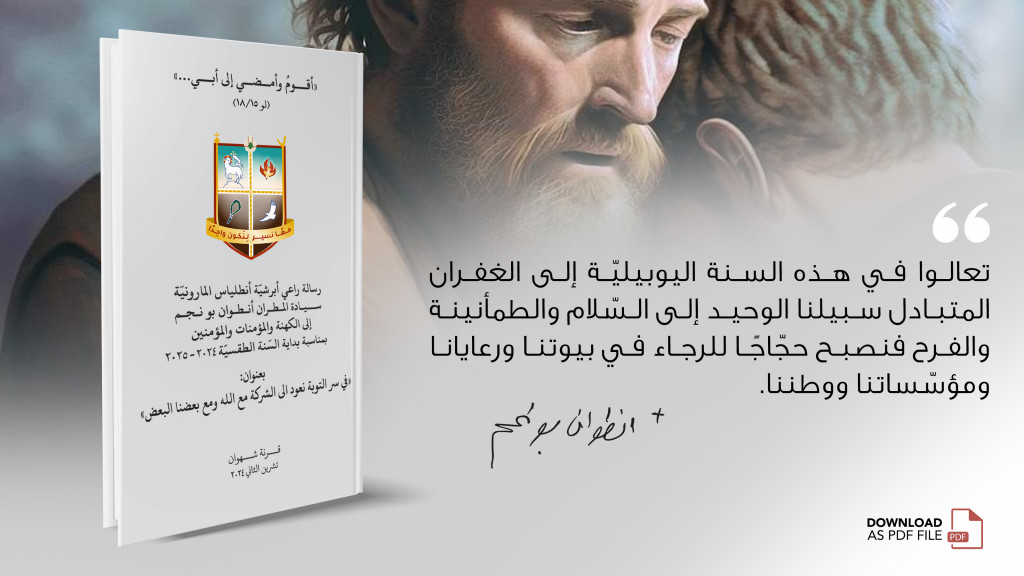وجهُ الله الجديد

وجهُ الله الجديد
المونسنيور جورج أبي سعد
مقالات/ 2021-01-14
وجهُ الله الجديد: الله الثّالوث الكاشف عن ذاتِه في التّاريخ وفي حياة الإنسان المعاصر
حديث للمونسينيور جورج أبي سعد - تفريغ دائرة الإعلام
كيفيّة انكشاف وجه الله الجديد للإنسان في قلب تاريخ الخلاص
الله سرٌّ عميقٌ لطالما حاول الإنسان أن يغوص في البحث عنه، علّه يدركه. وعند الحديث عن تجلّي الله، وكشفه عن ذاته، لا يمكن أوّلًا إلّا أن نفكّر بالعقل البشريّ وعظمته ومحدوديّته في آنٍ معًا. هو عظيم لأنّه قادرٌ على الدّخولِ في سرِّ الله، أي أن يَفهمَ حقيقتَه، ولو كان فَهمه لها غير كامل. ففي بحثِهِ عن حقيقةِ الله وفي دخولِه في سرِّه، يجدُ العقل البشري نفسَه أمام حدودٍ لا يمكنه أن يتخطّاها. فهو قادرٌ على الاعتراف بوجود الله وعلى تقدير جماله وعظمته من خلال النّظر إلى جمال الخليقة وعظمتها، إذ لا بدّ على الخالق أن يكون أعظم من المخلوق. إلّا أنّ الله، أمام محدوديّة العقل، يتدخّل فيعطي ما يُعرَف بالـ "الوحي"، أي أنّه يكشف عن ذاته للإنسان. لذلك، بدأ الله عبر التّاريخ، الكشف عن ذاته تدريجيًّا، بدءً مع شعب العهد القديم ووصولًا إلى العهد الجديد حيثُ " بعد أن كلّم الله الإنسان بأشباهٍ شتّى، كلّمه بابنه يسوع المسيح " (عب 1: 1)
وبالعودة إلى أولى تجلّيات الله في العهد القديم، من حيث اختبار الإنسان معه، نجد أنّ الله تجلّى أوّلًا مخلّصًا، قبل أن يتجلّى خالقًا. وقد كان ذلك من خلال حدث خروج الشّعب اليهوديّ من أرض مصر، حين اختبر الشعب إلهًا يهتمّ لأمر شعبه، ويسمع صراخه، فيأتي لنجدته. فهو إذًا إلهًا مخلِّصًا، أمينًا لعهده مع الشّعب، وما العهد سوى علاقة حبٍّ مُتبادلٍ تربط بين الله والشعب، وتجعل الله قريبًا من الإنسان، حاضرًا في تاريخ هذا الأخير كي يظهر له عن محبّته، ومنتظرًا أن يُبادله الإنسان علاقة الحبّ هذه، من خلال عيشه على حسب الشّريعة: جواب الإنسان على حبّ الله. وهذا الاختبار، أظهر الله على أنّه يعتني بالإنسان، فبدأ ينجلي تلقائيًّا الوجه الأبويّ لله، فهو يعتني بشعبه كما يعتني الأب بأولاده، مُؤمّنًا لهم الحاجات الماديّة والروحيّة. هذه هي باختصار مسيرة تجلّي وجه الله في التّاريخ، والّتي فيها يُذكر الروح القدس، أو روح الله، كما يُذكر كلمة الله أو حكمة الله.
إلّا أنّه لا يمكن الاعتبار بأنّ في ذلك ذكر للثّالوث، فإنّنا نرى فيهم، على ضوء العهد الجديد، علامات تُشير إلى الثّالوث دون أن تعبّر عنه صراحةً. فأوّل تجلٍّ علنيٍّ للثّالوث كان في اعتماد يسوع المسيح في نهر الأردنّ حين دوّى صوت الآب من السّماء يشهد أنّ الابن المُعمَّد في النّهر هو ابنه الحبيب، والرّوح القدس قد نزل وحلّ على رأس الابن في شبه حمامة. ففي معموديّة يسوع المسيح في نهر الأردنّ، تجلّى الآب من خلال الابن، أي أنّ الانسان تعرّف على وجه الآب من خلال وجه يسوع المسيح. وفي حياتنا اليوميّة، نواجه مشكلة كبيرة مع صورة الله، والسؤال الأساسي الّذي نطرحه على ذاتنا هو أي إله نعبد. هل أعرف إلهي جيّدًا؟ فأحيانًا كثيرة، وجه الله مشوّهٌ نظرًا لتصوّرات خاطئة نضعها عنه، وهذا ما يعيق العلاقة معه ويشكّكنا بمحبّتنا له ويُفقدنا ثقتنا به. وهنا الدّور الأساسيّ الّذي قام به يسوع، ألا وهو الكشف عن وجه الآب الحقيقيّ: " من رآني رأى الآب " (يو 14: 9). وبيسوع المسيح تجلّى وجه الله بأبهى صورته في حدث الصّليب، فنفهم إذًا ما قاله يسوع للآب السّماوي: " لتكن مشيئتك " (متى 26: 42). فإنّ مشيئة الآب هي الكشف عن وجهه الحقيقيّ للإنسان، وجهه الّذي هو المحبّة. وقد قَبِلَ يسوع المسيح أن يكشف عن وجه الله " المحبّة " حتّى الصّليب حيث كانت ساعة المجد بحسب الإنجيليّ يوحنّا. ففي مشهد الصّليب، تأخذ عبارة يسوع: "من رآني رآى الآب"، ملء معناها، حيث أظهر لنا الآب عِظَمَ محبّته للإنسان، وقد شكّل هذا المشهد كشفًا كاملًا لحقيقة وجوهر الله.
حين كلّمنا يسوع عن الرّوح القدس، لم يذكره على أنّه " قوّة " فقط، ولكن أظهره أيضًا على أنّه " معزٍّ آخر " (را يو 14: 16) أي أنّ يسوع هو المعزّي الأوّل، والرّوح هو المُعزّي الآخر الّذي يسكن في المؤمن ويكون معه. هو الرّوح الّذي يقول عنه القديس بولس أنّه الرّوح الّذي يُقدِّس، ومَنِ الّذي له قدرة التّقديس سوى الله القدّوس؟ من هنا نرى أنّ بيسوع المسيح تمّ الكشف عن وجه الله " المحبّة " على أنّه الثّالوث: الآب والابن والرّوح القدس. والكنيسة تحاول منذ بداياتها وحتّى اليوم، أن تغوصَ في هذا السرّ العظيم بهديِ الرّوح القدس، في مسيرة اكتشافٍ دائمٍ ومتواصل. فسرّ الله العظيم، يعكس عظمة العقل البشريّ، فإذا كان الله يكشف عن ذاته، فإنّ العقل البشريّ قادرٌ أن يفهمَ، على أنوار الرّوح القدس، هذا السرّ العظيم، الّذي لا يُسبر غَوره. فبقدر ما يغوص الإنسان فيه، يبقى هذا السرّ جديدًا غير محصور في فكرٍ بشريّ. وهذا ما يسمّيه التّقليد السّريانيّ " بالاندهاش "، الّذي لا يقتصر على الحياة الزمنيّة فقط، ولكن يستمرّ أيضًا في الحياة السّماويّة حيث لا تنفكّ النّفس البشريّة تغوص في اكتشافها لسرّ الله الثّالوث. فانطلاقًا ممّا سبق، نفهم أنّ الإنسان لن يتمّكن يومًا من القول أنّه اكتشف سرّ الله بشكلٍ كامل، كما يمكنه أن يكتشفَ ويحويَ حقائقَ زمنيّة ملموسة، ولكنّه يبقى دائمًا في مسيرة غوصٍ في سرّ الله الثّالوث، وهذه المسيرة هي له مصدر فرح.
وعندما نأتي على ذكر الله بذاته، هل يمكننا فعلًا أن نتحدّث عنه؟ هل نستطيع أن نتحدّث عن الله بجوهره كثالوث؟ فمن خلال ما كشفه الله للإنسان في تدبيره الخلاصيّ، يفتح المجال أمام الإنسان كي يتأمّل بالله في جوهر ذاته، مع العلم أنّه مهما كان تأمّله عميقًا، ومُعبّرًا عنه بلغةٍ فصيحة، تبقى معرفته مقتصرةً على تعابيرٍ بشريّةٍ ناقصة ولن تشكّل سوى مقاربة بسيطة وغير كاملة لهذا السرّ العظيم. ففي الكنيسة، وعبر مجامع كثيرة، محاولات عديدة لتفسير سرّ الثّالوث، وقد ظهرت عندها بدعٌ كثيرة حول هذا الموضوع. لذلك، تبقى المحبّة، وهي سرٌّ بحدّ ذاتها، هي الّتي تساعد الإنسان على فهمٍ أعمق لسرّ الله الثّالوث، لأنّ الثّالوث هو شركة حبٍّ تجمع بين الآب والابن والرّوح القدس. وبما أنّه شركة حبٍّ، لا بدّ أنّ يكون ثالوثًا كي يجد في ذاته من يسكب فيه حبّه، وهذا ما يجعل منه جوهريًّا شركة حبّ. والبابا يوحنّا بولس الثّاني يصفه بدوره " كعائلة ". وهذا الحب تجلّى بالتجسّد، أي أنّ الله أعطى ذاته للابن والابن أعطى ذاته للآب " وحركة الحب فيما بينهم هو الثّالوث " (مار أغسطينوس). وعلى ضوء هذا الثّالوث نفهم معنى الخلق، حيث أراد الله أن يوسّع هذه الشّركة، فخلق الإنسان على صورته ومثاله وأراده أن يشترك معه في فعل الحبّ ذاته. فمن خلال عطيّة الله، ندخل في هذه الشركة مع الثّالوث. فهو حياةٌ منفتحة على الحب وأساس الخلق والإنسان كما أنّه الغاية. ونحن بدورنا نتوق في حياتنا لكي نصل إلى هذه الشّركة مع الثّالوث. فالمفتاح الأساسيّ للدّخول إلى معرفة هذا السّرّ هو الإيمان الّذي يُدخِلُنا في معرفة شخصيّة مع هذا الإله.
كيف يمكننا اليوم أن نتعامل مع الله الثّالوث في حياتنا؟ وما الّذي يتغيّر في حياتنا إن لم يكن الله ثالوثًا؟
إذا كان التجلّي قد بدأ من الآب إلى الابن حتّى الرّوح، فالعلاقة تبدأ بطريقة مُعاكِسة. فهي تبدأ مع الرّوح الّذي يعرّفنا على المسيح بعلاقة شخصيّة غير نظريّة، كما أنّه أيضًا الحياة الإلهيّة فينا. فنحن نؤمن أنّ الله قد صار إنسانًا كي يألِّه الإنسان، باعثًا فيه روحه القدّوس كي يقدّسه، وهذا الرّوح هو في داخل كلّ معمّد كي يحقّق الاتّحاد الكامل بالمسيح ومن خلاله البنوّة للآب. وهنا نفهم قول القديس بولس بأنّ الرّوح يصرخ فينا أبّا أيّها الآب (را غل 4: 6)، أي أنّ الرّوح القدس هو الّذي يجعل المؤمن ابنًا بواسطة الابن، أي يجعلنا نعيش البنوّة نفسها الّتي عاشها يسوع المسيح مع الآب: لذا يمكننا أن نتوّجه للآب فنناديه: " أبّا " كما فعل يسوع المسيح. إضافةً إلى ذلك، الروح القدس هو روح الوحدة الّذي يوحّدنا بالابن والآب، حيث تصبح الحياة الأبديّة فينا اليوم. فإذا كانت السّماء هي ملء الشّركة مع الثّالوث، فالرّوح القدس هو الّذي يجعل المؤمن يعيش السّماء الآن، مُدخلًا إيّاه في حياة القيامة الّتي تبدأ اليوم بفعل الرّوح القدس إلى يوم بلوغ ملء قامة المسيح. فالروح القدس إذًا، يُدخل المؤمن من جهّة في شركة مع الله الآب، حيث تكون هذه الشّركة هي في طور النموّ يوميًّا إلى أن يصبح المؤمن واحدًا مع الآب بيسوع المسيح. ومن جهّة أخرى، يُدخِلُنا الرّوح القدس في شركة مع الآخرين، لأنّ الرّوح الّذي يملأ كلّ مؤمن هو روح واحد. وهذه الوحدة مع الآخرين، تعكس في حياتنا وحدة الثّالوث بذاته، وهي وحدة في المحبّة الإلهيّة. وهذا الاتّحاد يصبح بدوره علامةً لغير المؤمنين فيدعوهم إلى الإيمان بالإله الواحد المثلّث الأقانيم. وهذا ما أكّده يسوع في صلاته الأخيرة حين قال: " ليكونوا واحدًا كما أنا وأنت واحد... فيؤمن العالم أنّك أرسلتني " (يو 17: 21). وهذه هي الأعجوبة الكبرى – أعجوبة الوحدة، التّي يحقّقها الرّوح القدس فتجعل النّاس يؤمنون أكثر من الأعاجيب الأخرى. وكلّ مؤمن مدعوّ في كلّ وقت كي يجسّد هذه الوحدة في حياته، كي تنعكس في هذه الأخيرة حياة الثّالوث. فدعوة الكنيسة في كلّ وقت أن تكون أيقونة الثّالوث من خلال عيشها للوحدة على مثال الثّالوث. وما الأيقونة إلّا تجسيد منظور لحقيقة غير منظورة. ومن هنا، عندما يعيش المؤمن أيضًا الوحدة في حياته مع الآخر، حيث يعكس بذلك حقيقة الثّالوث الواحد في الجوهر، يشهد بدوره عن هذه الوحدة أمام النّاس أيضًا. إنّ الرّوح القدس هو في آن معًا صانع الوحدة ولكنّه أيضًا صانع التنوّع، فهو يُعطي مواهب متعدّدة وخدم متعدّدة... فيصبح عندها التنوّع غنىً، وغنى الآخر فعل حبٍّ من قبل الواحد للآخر لأنّ التنوّع هذا هو لخدمة الجماعة. هذا ما يُعرف بشركة القدّيسين.
لذلك، العمل الأوّل الذي يحقّقه فينا الرّوح القدس، هو عمل الوحدة والشّركة من خلال عيش محبّة الله الّتي أفاضها في قلوب المؤمنين بالرّوح القدس. فالمحبّة المدعوّون أن نعيشها ليست بقوّتنا: فليس بقوّة الإنسان أن يحبّ الآخر كما أحبّه يسوع، ولكنّ الرّوح القدس يجعله قادرًا على ذلك. إنّ محبّة الله أُفيضت في قلوبنا بالرّوح القدس، ومن خلاله، يصبح الإنسان قادرًا على أن يحبّ كما الله، هذه المحبّة الّتي تُعطي ذاتها وتجد في ذلك فرحها. فالمحبّة بذاتها تجعل الإنسان يعيش الثّالوث في حياته اليوميّة، كعلاقة ثالوثيّة جوهرها المحبّة. ومن هنا نفهم جيّدًا كيف أنّ الإنسان مخلوقٌ على صورة الله. فهو سرٌّ لا يمكن فهمه إلّا على ضوء سرّ الثّالوث، كما أنّه بتكوينه كائنٌ علائقيّ متمحور حول الحبّ الّذي يعطي ذاته. وبناءً على ما تقدّم، يبقى الصّليب علامة الإنسان الحقيقي الذّي يحبّ كما الله يحبّ. هذه العلاقة المرتبطة بالحب، هي هويّة الإنسان العميقة، حيث يصبح هذا الإنسان قادرًا أن يصل إلى ملء قامة المسيح من خلال الإكتمال بالحبّ الّذي هو القداسة، والتي بدورها تتحقّق حين يفهم الإنسان المعنى الحقيقي في أن يكون مخلوقًا على صورة الله كمثاله، ويفهم دعوته الأساسيّة وغايته ألا وهي الوصول إلى ملء الشّراكة مع الله الواحد مثلّث الأقانيم.