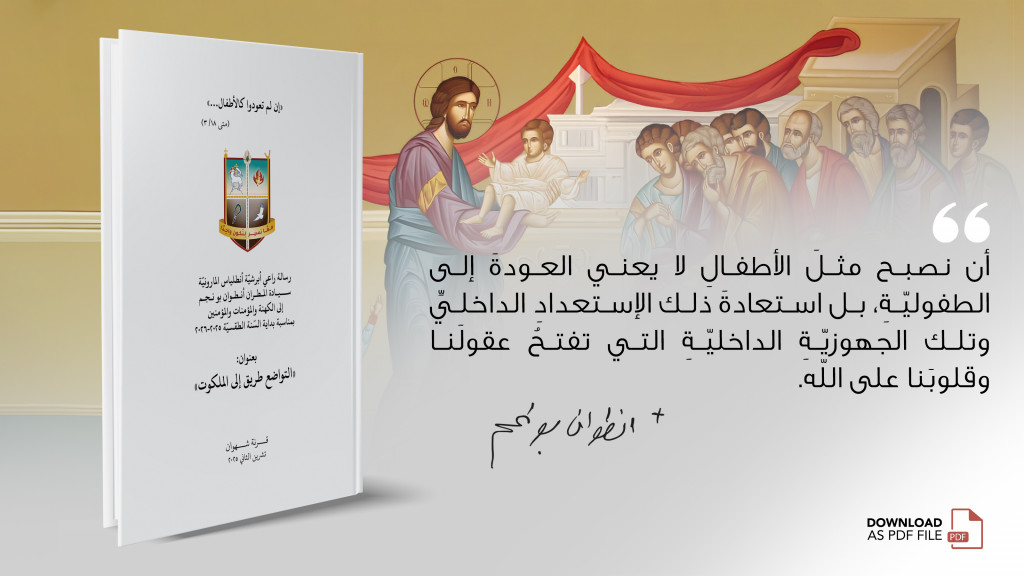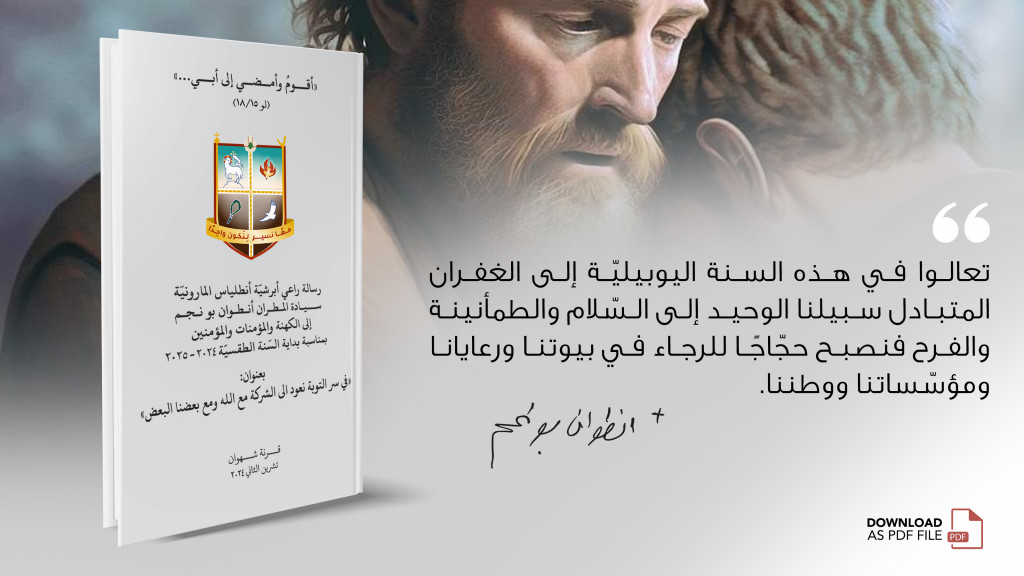هل ثمّة حلول جدّيّة لمأزق الحكم في لبنان؟

هل ثمّة حلول جدّيّة لمأزق الحكم في لبنان؟
الأب صلاح أبوجوده اليسوعيّ
مقالات/ 2020-09-01
"يمكن السيطرة على الناس من خلال إثارة أهوائهم بدل الاهتمام بمصالحهم"(غوستاف لوبون)
بات من الواضح أنّ النظام الذي قامت عليه دولة لبنان التي نحتفل بالذكرى المئويّة لتأسيسها، ويجمَع بين ترتيبات الحكم الطائفيّة وعناصر الديموقراطيّة الحديثة، غير قابل للحياة. وليست هذه الملاحظة بالجديدة، فقد سبق أن وُضِع النظامُ القائم موضع تساؤلٍ في أثناء أزمنة الأزمات السياسيّة والكيانيّة الكبيرة التي عرفها لبنان. وليس جديدًا أيضًا أن يطرح السياسيّون التقليديّون الطائفيّون، أي القائمون على هذا النظام، حلولاً لمأزق الحكم، منها الفدراليّة أو إلغاء الطائفيّة السياسيّة أو الدولة المدنيّة أو العلمانيّة. إلاّ أنّ اللّافت في هذا السياق بقاء هذه الطروحات على مستوى العناوين أو الشعارات، إذ لم تُترجم يومًا في مشاريع جدّيّة وعلميّة قابلة للتطبيق، فضلاً عن أنّها تؤدّي إلى تفاقم النظام الطائفيّ، وإثارة النعرات الطائفيّة والمذهبيّة. وبكلام آخر، تؤدّي طروحات السياسيّين التقليديّين إلى عكس ما ترمي إليه ظاهريًّا. ويكمن السبب في أنّ تلك الطروحات "التجديديّة" أو "الإصلاحيّة" تخفي مناورةً تهدف إلى كسب المزيد من السلطة أو الحصول على المزيد من الامتيازات.
وفي الواقع، فإنّ طريقة طرح تلك المشاريع-العناوين تجري على نحوٍ يوقظ المشاعر الطائفيّة الكامنة دومًا في نفوس اللبنانيّين، ويؤدّي إلى تأجيج الأحكام المسبقة والشكوك والخوف من الآخر الخصم. وفي حين أنّ نتائج هذا العمل مأسويّة على المجتمع، إذ تعزّز صورةَ المجتمع-الفسيفساء، فإنّها تمثِّل غنيمةً لا تُقدَّر بثمنٍ للمرجعيّة الطائفيّة السياسيّة التقليديّة لسببين: الأوّل، توطِّد تلك المرجعيّةُ، من خلال مناورتها، موقفها تجاه خصومها الداخليّين بفضل تعزيز تمثيلها طائفَتها؛ وثانيًا، تزيد من فرض ذاتها قيادةً لا غنى عنها ضمن طائفتها، وضمانةً وحيدة لمصالح أتباعها وديمومةِ إرثهم الطائفيّ، بل وبقائهم في البلاد.
لذا، فإنّ مشاريع المرجعيّات السياسيّة التقليديّة للخروج من مأزق الحكم ليست، بالعمق، إلاّ استغلالاً دائمًا وتصاعديًّا للشعور الطائفيّ بل والمذهبيّ، يحصل غالبًا بواسطة خطاب شعبويّ، يحوِّل الجماعةَ الطائفيّة تدريجيًّا إلى مجرّد جمهورٍ يختبر تزايدَ المسافة التي تفصله عن "جمهور الطائفة الخصم"، ولا يَعُد يفصل بين خير الجماعة الطائفيّة وخير المرجع السياسيّ-الضمانة. ولا عجب أن تتّخذ الأمورُ هذا المنحى؛ ذلك أنّ التعبئة الشعبويّة تُضحّي بالعقلانيّة لصالح العاطفة بل وحتّى الغريزة، إذ إنّ الجمهور يخضع من دون أيّ تفكير نقديّ لـِمَن يُقدِّم نفسه منقذَه والمدافعَ عن حقوقه وحرّيّته وهويّته وشرفه. وإزاء هذا الواقع، يصبح الجمهورُ جاهزًا للقيام بأعمالٍ لا خارجةٍ على القانون فحسب، بل ومتهوّرة دفاعًا عمَّا أوحته مرجعيّته بأنّه حقّ له، أو دفاعًا عمَّا يراه تعرّضًا لمرجعيّته وقد اكتسبت صفةً مقدَّسة. وما يقوله غوستاف لوبون ينطبق على هذا الواقع: "إنّ ما يسود روحَ الجماهير دومًا، ليست الحاجةُ إلى الحرّيّة، بل الحاجة إلى العبوديّة. فالجماهير تتوق توقًا شديدًا لتخضع غرائزيًّا لـمَن يُعلن عن نفسه سيِّدًا عليها".
يفرِض مثلُ هذا الجوّ الطائفيّ طاعةَ المرجع السياسيّ على نحوٍ تلقائيّ، من دون نقاش أو تشكّ. وفي كثير من الأحيان، يتحوّل هذا المرجع نفسه في مخيّلة الجمهور رمزًا للدِّين نفسه واستمراره، إذ يتفاقم الخلط بين الدِّين بصفته رسالةً شاملةً لا تنحصر بزمانٍ ومكانٍ وتخصّ البشريّة كلّها، والطائفة بصفتها مجموعة محصورة ثقافيًّا وجغرافيًّا وسياسيًا وعرقيًّا. ولا عجب أن يتّخذ خطابُ المرجع السياسيّ الطائفيّ إذ ذاك طابعًا شبه عقائديّ يحلّ محلّ المعرفة كما يتكلّم عليها أفلاطون، وتقوم على اعتماد الحقيقة معيار المعرفة التي يتمّ التحقّق من صحّتها من خلال الاختبار. فإنّ كلمات المرجع السياسيّ الطائفيّ تُغذِّي العقول بطريقة تعبويّة عمياء، وتصبح معيار العمل والحجّة التي لا جدال بشأنها. فإذا سارت الأمور تبعًا لمصالح المرجع السياسيّ، يبقى الجمهور ساكنًا، وإذا تطوّرت في اتّجاه معاكس، يكون مستعدًّا للتحرّك بحسب إشارات مرجعه.
قد يندهش المراقب الخارجيّ عندما يرى اللبنانيّين جميعًا مُفلسين، مهانين، مُرهَقين بسبب نظام حكمهم ونهجِ حكّامهم، وفي الوقت عينه لا يتوصّلون إلى إنجاز وحدة وطنيّة صلبة، وإنتاج طبقة سياسيّة جديدة قادرة على إقامة دولة الحقّ والقانون والمحاسبة. بل، على نقيض ذلك، يراهم منقسمين، متأهّبين للدفاع عن جلاّديهم مهما كان الثمن. ولكن هذه هي نتيجة منطق الجمهور عندما يسود، ولا سيّما عندما يتأصّل الخطابُ الشعبويّ في العناصر الثقافيّة الخاصّة بالطائفة التي تورث ثمّة نظرةً معيّنة إلى لبنان ومحيطه. وتجاه هذا الواقع، تصبح المواطنيّة المؤسَّسة على المواطن الفرد هدفًا يصعب بلوغه، لأنّ الفرد يذوب في جوّ جماعته، ولا سيّما عندما تتحوّل الجماعة إلى جمهور. لذا، فإنّ الأفراد الذين لا ينضوون تحت شعارات مرجع طائفتهم السياسيّ، يُهمَّشون إنْ لم يُتّهموا بالخيانة أو الجبن أو غياب الرؤية عندهم. إنّ الفرد في الحالة الطائفيّة "يَفقد فكرة وجوده نفسها"، كما يقول فاكلاف هافيل، ويصبح عرضةً للتلاعب وشبهَ آلةٍ تُدار تبعًا لرغبات من يمسك بها.
في ضوء ما تقدَّم، يتّضح أنّ كلام المرجعيّات السياسيّة الطائفيّة التي تُمسك بمفاصل السلطة كلّها على سياساتٍ أو مشاريع تؤول إلى قيام دولة ديموقراطيّة مؤسَّسة على فكرة المواطن والمساواة في الحقوق والواجبات والولاء للوطن وحده، مجرّد وهمٍ أو مناورة.
انتقد الكثير من المراقبين انتفاضة 17 تشرين الأوّل 2019، لأنّهم رأوا أنّها انحرفت سياسيًّا بعد انطلاقتها بأيّام، وأصبحت وكأنّها في معسكر معيّن، فضلاً عن كثرة مطالبها إلى حدّ ضياعها، وخرقها من قبل أحزاب. ولعلّ هذه الملاحظات صحيحة نسبيًّا. غير أنّ تلك الانتفاضة في مرحلتها الأولى تمثِّل حدثًا مؤسِّسًا لدولة لبنان الجديد، لا يمكن إغفاله. فما حصل يُبيِّن أنّ ثمّة وعيًا وطنيًّا شاملاً لاطائفيًّا يترسّخ عند شريحة واسعة من اللبنانيّين الذين نزلوا إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد بسلميّة مذهلة، وروحٍ تشهد على ولادة المواطن الفرد الذي يريد الانتماء إلى دولته، وخدمة خيره وخير بلاده، وعيشه في ظلّ نظام ديموقراطيّ يضمن الشفافية في ممارسة الحكم ويوفِّر إمكانيّة المحاسبة. بالطبع، تحتاج هذه الروح التي تنتابها من حينٍ إلى حينٍ بقايا الطائفيّة، إلى أن تتقوّى وتتظهَّر في برامج تشمل كلّ الحقول على أسس العمل السياسيّ غير الطائفيّ. ليس الأمر سهلاً، بالطبع، ولكنّه ليس مستحيلاً، لأنّ حدث 17 تشرين الأوّل أطلق مواجهة لا رجعة فيها؛ مواجهة بين الشعب والجمهور، والمواطن والخاضع للزعامات الطائفيّة. منذ 17 تشرين الأوّل تتواجه رؤيتان للبلاد: رؤية ترى لبنان دولة محكومًا عليها بالضعف والتشرزم والفساد والاستسلام للطائفيّة بصفتها أمرًا واقعًا لا خلاص منه، ورؤية لبنان الجديد الذي يؤمن بالديموقراطيّة والحرّيّة وحقوق الإنسان. منذ 17 تشرين الأوّل يتواجه حُبَّان: حبّ الوطن وحبّ الزعامات الطائفيّة. إنّها معركة طويلة وشاقّة. ولكن، كما يقول المؤرِّخ هربرت براون: "في وجه الصخرة، يربح سبيلُ الماء دومًا، لا بالقوّة بل بالمثابرة".