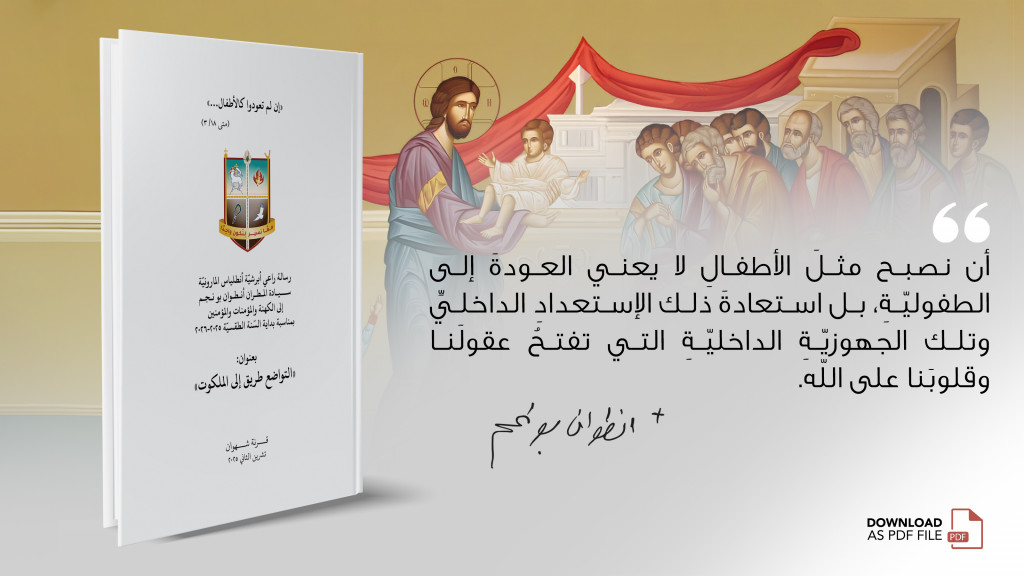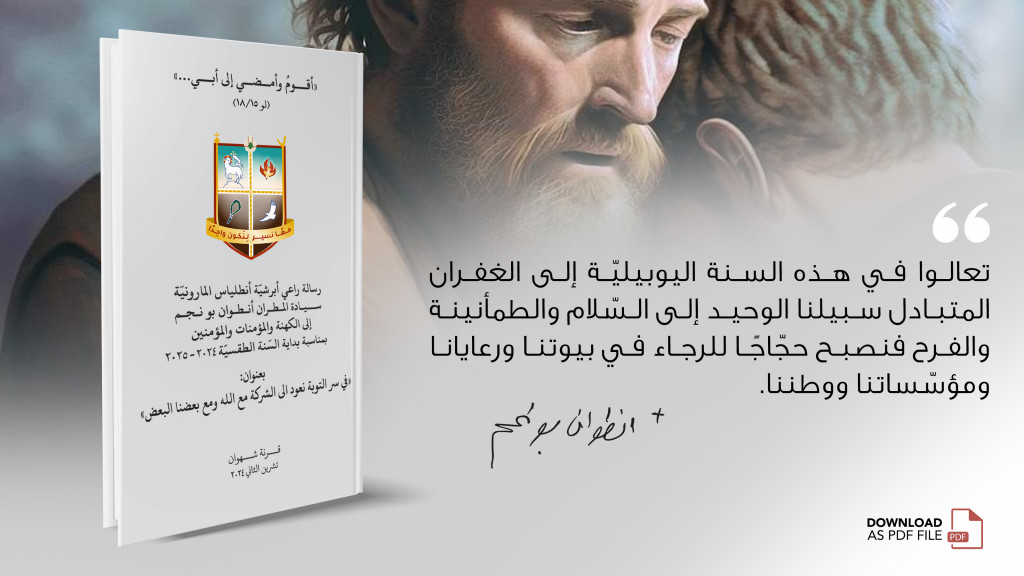السلام الداخلي والإفخارستيّا

السلام الداخلي والإفخارستيّا
الخوري جورج كامل
مقالات/ 2016-12-27
في أحد القداسات الاحتفاليّة حيث كان للجوقة ما تقدّمه وتفتخر به بعد تمارين وتدريبات مرهقة، وعائلة المرحوم المتّشحة بالسواد كانت قد انْهَمكت في تحضير وليمة فاخرة دعت إليها الأهل والأقارب والأصدقاء ليترحّموا على فقيدهم الغالي، الذي يرخص لأجله كلّ غالٍ وثمين. وخدّام المذبح قاموا بجهد كبير لتليق خدمتهم بالمناسبة والحضور. والكاهن حضّر وعظة يمتدح فيها المرحوم وعائلته السخيّة. وحشد من الرسميين والمواطنين العاديين تحمّلوا بعض الملل لأنّ المرحوم «بيستاهل» وأهله «بيعِزّوا علينا»... كلّ ذلك، بالإضافة إلى الذين لا تربطهم بأهل الفقيد أيّة قربى وأتوا إلى القدّاس كما اعتادوا أن يفعلوا في كلّ أحد، لأنّه يوم الربّ، ولأنّ واجباتهم المسيحيّة الرئيسة تحثّهم على المشاركة في الذبيحة الإلَهيّة، ليرضى الله عنهم ويريح ضميرهم ويردّ عنهم وعن أحبّائهم... تجمّع هؤلاء الحضور وكلٌّ منهم يحمل معه شيئاً، أو على الأقلّ، شخصه الكريم، والحياة قُرْض ووَفى...
وفجأةً يقطع هذه الأجواء الجديّة والرسميّة صراخ طفل يضحك ويركض مستغلاًّ المساحة الواسعة في الممشى المتاحة له، تعويضاً عن بيته الضيّق، وهو غير مهتمٍّ للقال والقيل ولا لنظرات الحاضرين الذين يراقبون كلّ حركة وكلمة، فيحاولون اسكاته... ويزدادون حميةً في ذلك، خاصّةً عندما يمرّر الخوري نظره باتّجاهم فيشعرون بالإحراج.
في حدثٍ مماثل أجابَ يسوع هؤلاء بِحزمٍ ووضوحٍ قائلاً: «دعوا الأطفال يأتون إليّ ولا تَمنعوهم، فإنّ لأمثالهم ملكوت السماوات». لكن في الواقع، ما أتى هذا الطفل يصنع في عالم الكبار؟ وماذا يفهم مّما يجري حوله؟ ربّما لم يفهم الشيء الكثير... وأيضاً الكبار، أظنّهم يشاركونه الغربة نفسها. لكنّ الفارق الوحيد يكمن في اعتقادهم بأنّهم يأتون وقد حملَ كلّ منهم شيئاً يقدّمه بفخر. أمّا الطفل فيعلم تماماً أنّه لا يملك شيئاً، يضاف إلى كلّ ذلك محاولاتهم اليائسة لأن يشعروه بأنّه متطفّل ودخيل ولا يصدر عنه سوى الإزعاج والإحراج. لكنّ الطفل وبخلاف هؤلاء الكبار لا يضع على وجهه أيّ قناع ولا يحاول التصنّع في ما يقوم به بشكلّ عفويٍّ وبديهيّ. الفارق بينه وهؤلاء العمالقة المحيطين به أنّهم يجلسون على مقاعد غير مريحة وينتظرون نهاية القداس، أمّا هو فمرتاح على وضعه. وهذه الراحة تنبع من كونه يدرك تماماً أنّه محور حبّ واهتمام ورعاية أهله، وليس عليه أن يقلق في شأن ذلك كما يفعل الكبار. الكبار يقومون بجهود حثيثة ليحصلوا على رضى الناس والله، أمّا هذا الطفل الشقيّ فيعلم تماماً أنّه مهما صنع فسيبقى بنظر أهله طفلهم المحبوب. هنا تكمن كلّ المفارقة.
والدعوة توجَّه إلينا «اليوم»، نحن الذين نلهث في البحث عن السعادة وسط ضجيج العالم وضوضائه، ونَهتمّ بأمور كثيرة ويغيب عن بالنا المطلوب الأوحد، «إن لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات». فتعالوا إلى القداس، ولا تحملوا معكم شيئاً، تشبّهوا، ولو لمرّة، بأطفالكم. أوَلَم تعلّموهم أن يقولوا «شكراً» عندما يقدّم لهم أحد شيئاً؟! ألا ترون الفرح يرتسم على محيّا الطفل عندما يقبل هديّة من أحد؟ وأجمل وأروع من كلّ هدايا الأرض والسماء أن يدرك المرء أنّه محبوب وأنّ أحداً ما يهتمّ لأمره، ولا يبتغي بالمقابل منه شيئاً سوى أن يقبل حبّه المجّانيّ! والسلام الداخلي هذا، الذي يرتسم على محيّا الطفل ويتجلّى في سلوكه، لا يصدر عن فكر، ولا عن بعض كلمات وممارسات ظرفيّة، بل ينبع من علاقة حميمة وانتماء كيانيّ كانتماء الغصن إلى الكرمة والطفل إلى والديه. فإذا كنت تشعر في أعماقك الإنسانيّة باليُتم، أو على مثال عالم الاستهلاك الذي غزى قلوبنا، بأنّك مُلزَم بتسديد ثمن حبّ الله لك، فإنّك لن تدرك أبداً معنى الذبيحة الإلَهِيّة، حتّى ولو قرأت كلّ كُتُبِ اللاهوت.